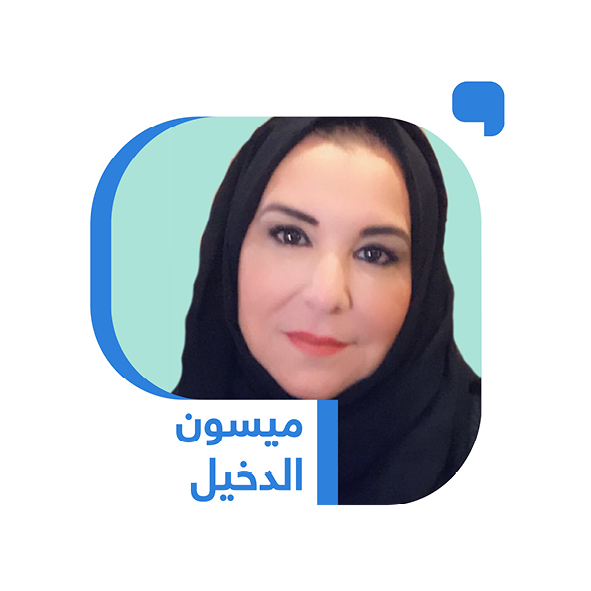خلال الصيف الماضي التقطت الكثير من الصور والمقاطع، فقط كي أشارك أحبّتي وطالباتي بما شعرت أنه مؤثر ومفيد، وكنت، في كل مرة أصوّر فيها مقطعا لأحدهم، أطلب منه الإذن مسبقا للتصوير والنشر، تماما مثلما فعلتُ مع شرطية أحببت
أن آخذ رأيها في عملها كامرأة في هذا المجال، وما النصائح التي تحب أن تشارك بها طالباتي ممن يفكرن بالانخراط في سلك الشرطة، كانت في منتهى الذوق والتعاون، وكان الحوار معها ممتعا ومفيدا حقا. هل صادفتُ مواقف مقززة أو خارجة عن حدود الذوق العام؟ نعم، صادفت كثيرا، ولكني لم أصور ولم أحكم، بل أكملت طريقي لأنه ليس دوري أن أراقب أو أبحث في هذه المواضيع التي لن يفيد نشرها، بل قد يشجع على التعدي على حقوق الغير.
شدتني مقالة كتبها الأديب حسن م. يوسف يقدم من خلالها اعتذارا علنيا عن لقطة أخذها لسيدة من الخلف، قام بتصوير الكتابة والصورة على لباسها، وكانت الصورة لفيل، وكتب فوقها «زبالة» باللغة الإنجليزية. الذي حرّكه فكرة أننا نرتدي ثياباً كتب عليها كلمات باللغة الأجنبية ولا نعرف معانيها، ونرتديها لمجرد أنها «موضة»، أو لأنها مختلفة! هل مر عليكم مثل هذه الحالات؟ بالنسبة لي مرّ عليّ كثير منها! وكم توقفت دهشة واستغرابا لبعض الكلمات التي تجعل شعر الرأس يستقيم في كل الاتجاهات على رأس القارئ الذي فهم معناها! فإن كانت طالبة كنت أقترب منها، وبكل هدوء وبصوت خافت لا يكاد يسمعه أحد سواها، أترجم لها المعنى، وأترك لها الحكم، وأمضي. أما إن كان الأمر في طريق عام فإنني أكتفي بالحالة التي تنتابني من الأسف والحزن على صاحب الرداء، وأيضا أمضي في طريقي.
نعود إلى اللقطة التي نشرها الأديب، جاءه الكثير من التعليقات التي لا تستغرب، بل تجلد هذه الأمة التي لا تقرأ، وتقلد، وتسير خلف الغرب على عماها! ومنهم من اعتبر الأمر تعديا على حقوق الغير بنشر صورة، ولو أنها من الخلف وبدون الرأس، بمعنى لن تُعرف مَن هي! لكن إحدى التعليقات كانت صادمة! لقد فسر الكاتب أن الصورة مع كلمة «زبالة» ما هي إلا حملة ضد رمي الأكياس البلاستيكية التي تسببت في موت الكثير من الفِيَلة التي التهمتها! قد تكون المرأة على علم بهذه الحملة وقد لا تكون، المهم أن الكلام لم يكن صادما بل توعويا عن حماية البيئة، ومنها الحيوانات.
لنا أن نستغرب، وعلينا أن نقوم بالتوعية، ولكن ليس علينا أن نصوّر وننشر! من يعلم كما قلت الخلفيات أو المعنى الآخر لما ظهر أمامنا كحالة شاذة أو منفرة! إن كنا في موقع نستطيع من خلاله العمل على التأثير على مَن حولنا، والعمل على التوضيح، وإظهار المعنى الصحيح، وكيفية تفادي مثل هذه المواقف فهذا أمر جميل، فلنقدِم ونفعّل هذه الحملات. لكن إن كنا ممّن لا تأثير له في المجتمع، وهنا أعني العلمَ والمعرفة والخبرة، فلا يحق لنا أن نتقدم ونتعدى على حقوق الغير لمجرد أن الأمر لم يعجبنا!
أعجبني حقا الموقف الكبير الذي اتخذه الكاتب حسن م. يوسف، حيث أعلن اعتذاره، وأوضح ملابسات الموقف، وأنا معه في أهمية ألا نقلد أو نلهث خلف الموضة دون أن ندرك ما المكتوب على ما نقتنيه من لباس أو أكسسوار، ومعه أيضا في أننا حين نخطئ يجب علينا أن نعتذر بنفس الطريقة أو الوسيلة التي قمنا بها في الإعلام عن الموقف، والأهم من هذا كله أن نتريث ونتأكد قبل أن نحكم على ما ظهر لنا من سلوكيات الآخر.
همسة أخيرة، لنتذكر أن هناك من يصله من الغير، مثل هذه الملابس المطبوع عليها كلمات خارجة عن الذوق العام أو الأدب والأخلاق، قد تكون على شكل هدايا أو تبرعات أو صدقات، والذي يرتديها لا يعرف القراءة والكتابة بلغتنا حتى يعرفها بلغة الغير، أو قد يكون ممّن لا يعرف أي لغة أجنبية! وقد يكون مَن أرسلها أصلا لا يعرف ما تعنيه، ولم يقصد أبدا الأذية، بل كان يطلب التقارب والمودة أو الأجر، المهم لو أننا توقفنا عن الحكم والتدخل، وبدأنا بالانشغال بمحاسبة أنفسنا أولا لكُنّا قد أرحنا واسترحنا. نريد أن نرتقي بالذوق العام؟ نحن نستطيع فعل ذلك بكل أدب وذوق وإنسانية، فالمعادلة سهلة ولا تحتاج إلى فكّ شيفرة لنتبعها.