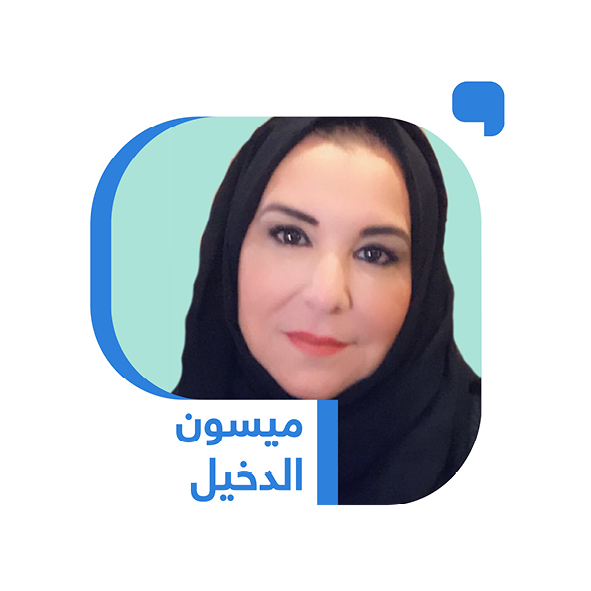وهنا أتوجه بحديثي إلى كل من يسلك هذا الطريق لكي يقيس أفعاله، هل هي متطابقة مع ما يلي؟ هل أنت الشخص الذي عندما يواجه الناس مشكلة يفكرون بك؟ هل أنت الشخص الذي عندما يحتاج الناس إلى المشورة يأتون إليك بسبب حكمتك وموضوعيتك واتساع علمك وعمق خبراتك؟ هل عندما يمر الناس بأزمة نفسية أو يعانون من حزن ويحتاجون إلى شخص يستمع إليهم ويتفهم منهم دون أن يحكم أو يعترض، يأتون إليك؟ هل أنت من يسارع إلى نجدة أخ أو صديق أو زميل عمل عرفت أنه يمر بضائقة مالية، فتجيش كل طاقاتك وعلاقاتك من أجل أن تجمع له ما يحتاجه؟ هل ساعدت طالب علم معسرا توقف بسبب عجزه عن توفير تكاليف الدراسة؟ هل ساعدت طالبا في شرح دروس يجد صعوبة في فهمها ومتابعتها؟ هل تشارك في علمك ومعرفتك وخبراتك من حولك لينمو ويتطوروا؟ هل تطوعت في إنشاء ملجأ، في بناء مسجد، في مؤسسة خيرية، في مدرسة، في جامعة، هل أسهمت على الأقل في بضع ساعات من حياتك اليومية في تنمية مجموعة من الشباب أو المراهقين بأن كنت لهم الصاحب والمرشد والمعلم والأخ؟ هل شاركت في حملة نظافة لشارع أو ترميم حي أو تجميل حديقة عامة وتزيينها؟ هل تصدّيت لظلم أو تعدٍّ في محيط أسرتك أو عملك أو مجتمعك؟.
ليس المطلوب أن تقوم بكل ذلك، بل ببعضه أو بما شابهه من أفعال بسيطة لكنها مميزة ومتكررة. المهم هنا أن المطلوب ليس أن تقوم بها للمجاهرة وإضافتها إلى السيرة الذاتية، بل المطلوب أن يعلم من ستقف إلى جانبه أنك ستدعمه حسب قدراتك وما تتيحه لك الظروف من التدخل والحسم، وأنك في الوقت نفسه لا تتأفف ولا تنتظر مقابلا ثم لا تتبع ما فعلت منًّا ولا أذىً.
أن تكون إنسانا أكثر من عادي هو ليس أن تعمل من أجل مجدك! فما الفائدة إن كنت تحرص على أن تجمع الألقاب أو المراكز لتظهر قبل اسمك أو بعده، ولا يستفيد من هذا العلم أو الفكر أو الخبرة أحد سواك! العلم أو المعرفة لم تعد تحسب من التحديات، فبضغطة زر على الحاسوب يصبح عالم المعرفة مفتوحا أمام ناظريك، وما عليك سوى أن تعرف كيف تختار الأفضل والأصدق. التحدي هو أن تحول كل هذه المدخلات إلى مخرجات نافعة للناس من حولك. وما الفائدة إن كنت تلقي المحاضرات أو تقيم الدورات ثم يخرج الناس منها كما دخلوا! وما الفائدة إن كنت تؤلف روايات أو تكتب أشعارا أو ترسم أو تمثل أو تخرج أو حتى تقدم برنامجا على المذياع أو الرائي، ولا يخرج الناس من عملك إلا بضياع الوقت، هذا إن لم يكن تشتيتا وانحطاطا بالذوق العام!
أن تكون إنسانا غير عادي هو كمن زرع شجرة يستفيد منها الطير والبشر دون معرفة الزارع، هو أن تحول سمادك إلى ثمار تفيد من حولك وأنت ترتقي وتنمو، هو أن تكون أنت القدوة، أن تكون القلب النابض، الروح الطيبة، والابتسامة المشرقة في حياة الآخرين. فهنالك من حوّل ألمه إلى أداة شفاء من خلال تحويل هذا الألم إلى دافع للعطاء ومساعدة الآخرين، وهنالك من حوّل عجزه إلى نقطة قوة واندفع من خلالها إلى عالم الإبداع والعطاء. وما الفرق بيننا وبينهم، رغم أننا نتشارك معهم نفس الأربع وعشرين ساعة كل يوم من حياتنا؟ قلب كبير لا يرى فرقا بين الناس، وإرادة وعزم وإصرار، وإضافة إلى ذلك كله رؤية النفس على أنها جزء من الكل، ليست جزءا فوق الكل!.
هموم كثيرة! ومتى كانت الحياة بلا هموم؟! مشاغل وتحديات وعقبات ومشاكل لا تنتهي! إن لم تكن كذلك لا تسمى حياة. ولكن لو فكر الناس العاديون بمن حولهم رغم ما يمرون به من منغصات، لوجدوا أنفسهم في صفوف الناس غير العاديين. ما الفائدة؟ إنها فوق التصور! يكفي أننا إذا تحولنا إلى أناس غير عاديين ارتقينا بكثير ممن حولنا إلى حياة أفضل، ولو تعطل تقدمنا، وقد يحدث أن يسبقك من ساعدت، لا يهم! المهم أنك في داخلك تبني قصرا من السلام وهذا بدوره سوف يؤثر على نفسيتك ويدفعك ويستمر في دفعك وإعطائك طاقة إيجابية تمكنك من الاستمرار رغم كل العقبات. ثم إن للعطاء والمشاركة لذة لا يعرف طعمها وحلاوة رحيقها إلا من ذاقها، و«من ذاق عرف» كما يقال، وبعد المعرفة والتذوق فإنه من المستحيل أن يتوقف أو يكلّ أو يملّ، وبذلك يصل بثماره إلى أكبر عدد من الناس، وهذه هي روح الإسلام، حركة ومساندة وارتقاء.
وفي النهاية نحن بحاجة إلى أناس غير عاديين، لأن العالم أصبح مليئا بالعاديين حتى المشاهير منهم!.