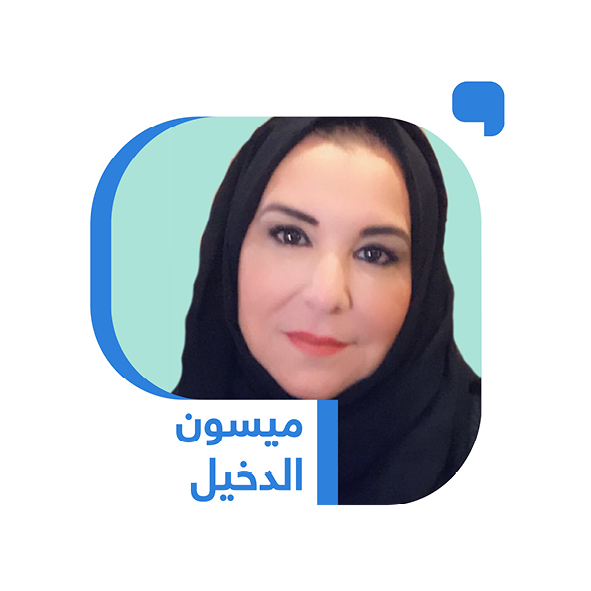يقول كن: إن جميع تلاميذ المدارس محرومون من عملية التعلم! بمعنى أن هناك من لا يستمتع به، وهناك من لا يستفيد منه، والسبب ليس لأننا لا ننفق ما يكفي من المال على ذلك، وهو هنا يتحدث عن أميركا، والشيء نفسه يمكن أن يقال عمّا يحدث في السعودية، رغم أنها تنفق قدرا كبيرا من المال على التعليم، بل أكثر من العديد من البلدان المتقدمة، نعم أحجام الفصول لا تتوافق مع المعايير بشكل أساسي، وكثير من البيئات التعليمية لا ترتقي إلى المعايير العالمية، ولكن هناك المئات من المبادرات التي تقدّم كل عام لمحاولة تحسين التعليم، المشكلة هنا أن كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ!
هناك ثلاثة مبادئ تزدهر على أساسها حياة الإنسان، وتتناقض مع ثقافة التعليم السائدة التي يتعين على معظم المعلمين العمل بموجبها كما يتعين على معظم الطلاب تحملها.
الأول: أن البشر مختلفون ومتنوعون، بينما التعليم المقدم اليوم لا يعتمد على التنوع، بل على المطابقة، وما يتم تشجيعه في المدارس هو معرفة ما يمكن للتلاميذ القيام به عبر نطاق ضيق للغاية من الإنجاز.
لقد قاموا في الآونة الأخيرة بالتركيز على تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، نعم هي ضرورية، ولكنها ليست كافية، فالتعليم الحقيقي يجب أن يعطي وزنا متساويا للفنون والعلوم الإنسانية والتربية البدنية. واليوم نجد زيادة كبيرة في أعداد التلاميذ الذين تم تشخيص حالاتهم، من قبل منسوبي المدارس غير المحترفين، على أنهم يعانون اضطراب نقص الانتباه! فماذا ننتظر إذا كنا نُجلس الأطفال ساعة بعد ساعة، ونشغلهم بتأدية أعمال كتابية منخفضة المستوى؟! يجب ألا يدهشنا بعدها إذا بدؤوا بالتململ، فما يعانونه ليس سوى مظهر من مظاهر الطفولة. إن ما يحتاجون إليه هو منهج دراسي واسع، يخدم مواهبهم المختلفة كمجموعات متنوعة في القدرات والمهارات والاهتمامات، وبالمناسبة فإن الفنون ليست مهمة فقط لأنها تعمل على تحسين نتائج الرياضيات كما أثبتت الدراسات، بل هي مهمة لأنها تخاطب أجزاء داخلية من كينونة الأطفال.
المبدأ الثاني هو أن الذي يدفع الحياة البشرية إلى الازدهار هو الفضول، فإذا استطعت أن تضيء شعلة الفضول لدى التلاميذ وجدتهم غالبا ما يتعلمون دون الحاجة إلى أي مساعدة إضافية، إن التعلّم من طبيعة الأطفال، والفضول هو محرك الإنجاز، ودور المعلم هو تسهيل التعلم، ولكن جزءا من المشكلة هو أن الثقافة السائدة في التعليم أصبحت تركز ليس على عمليتي التعليم والتعلم، بل على الاختبارات! الاختبارات مهمة نعم، ولكن لا ينبغي أن تكون الثقافة السائدة في التعليم، يجب أن تكون للتشخيص لدعم التعلم، لا لإعاقته، بمعنى أنه يتم تشجيع التلاميذ والمعلمين الآن على اتباع إجراءات روتينية بدلا من إثارة قوة الخيال والفضول.
المبدأ الثالث: إن الحياة البشرية مبدعة بطبيعتها، ومن أدوار التعليم إيقاظ وتطوير قدرات الإبداع هذه، وبدلا من ذلك، ما لدينا هو ثقافة التوحيد القياسي، والآن لا يجوز أن يكون الوضع بهذه الطريقة، فالدول التي تم تصنيفها على أنها الأفضل في التعليم تركز على تفريد التعليم والتعلم، لأنها أدركت أن التلاميذ هم الذين يتعلمون، ولذا يتعين على النظام التعليمي إشراكهم وإثارة فضولهم وإبداعهم من خلال تفريد التعليم، فهذه هي الطريقة التي تجعلهم يتعلمون، كما أنها وضعت مكانة عالية جدًّا لمهنة التدريس، حيث تدرك أنه لا يمكن تحسين التعليم إذا لم يتم اختيار أشخاص مميزين للتدريس، ومنحهم الدعم المستمر والاهتمام بتطويرهم مهنيًّا، فالصرف على التطوير المهني ليس تكلفة، بل هو استثمار، وكل الدول المتقدمة في التعليم تدرك ذلك جيدا. ونقلت تلك الدول المسؤولية إلى مستوى المدرسة لإنجاز المهمة. والقضية هنا أن التعليم لا يذهب إلى غرف اللجان في مباني الوزارة، وإنما يحدث في الفصول الدراسية وفي المدارس، والأشخاص الذين يقومون بذلك هم المعلمون والطلاب، فإذا سُحبت منهم حرية التصرف فإن التعليم سوف يتعطل!
ليس التعليم نظاما ميكانيكيا، إنه نظام بشري، لأنه يتعلق بالأفراد، أو الأشخاص الذين يرغبون في التعلم أو لا يرغبون فيه، وما نحتاج إليه لكي يشارك الطلاب والمهتمون، هو إنشاء برامج مصممة لإعادة التلاميذ إلى التعليم، تعتمد على تفريد التعليم والتعلم، تقدم دعما قويا للمعلمين، وتعمل على بناء روابط وثيقة مع المجتمع، ومناهج متنوعة، تُفعّل داخل وخارج أسوار المدرسة.
لقد شهدنا مؤخرا انتعاشا في بعض المناطق الصحراوية الجافة وتحولها، ولو لبعض الوقت، إلى مروج خضراء، بسبب كمية الأمطار التي هطلت عليها، ما يثبت أن هذه المناطق لم تكن ميتة، بل هي مجرد نائمة، فتَحْت السطح توجد بذور الاحتمال بانتظار الظروف المناسبة، وإذا كانت الظروف موائمة فالحياة لا مفر منها، وهذا ما يحدث عادة، تأخذ منطقة، أو مدينة، أو مدرسة، وتغيّر الحالة بأن تمنح الناس إحساسا مختلفا من الاحتمالات، ومجموعة مختلفة من التوقعات، ومجموعة أوسع من الفرص، وتُقدر وتثمن العلاقات بين المعلمين والمتعلمين، وتمنحهم حرية التصرف في الإبداع والابتكار فيما يقومون به، والمدارس التي كانت جرداء فكريا وعلميا سوف تنتفض وتنبض بالحياة.
القادة العظماء يعرفون ذلك، لأن الدور الحقيقي للقيادة في التعليم، سواء على مستوى الوزارة أو على مستوى المدرسة، ليس ولا ينبغي أن يكون للتحكم والسيطرة. إن الدور الحقيقي للقيادة هو التحكم في المناخ، بمعنى خلق مناخ من الاحتمالات، فإذا فعلنا ذلك فسوف يرتقي الناس إليه، ويحققون أشياء لم نكن نتوقعها، وهذا ما يسمى بـ«ثورة في التعليم»، وهي ما نحتاج إليه فعلا.