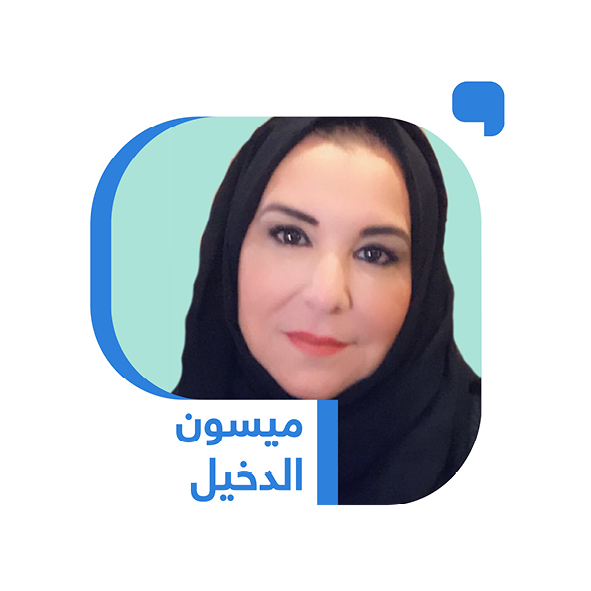تقدمت إحدى الزميلات بشكوى زميلة لها، وسارع الجميع إلى تقديم الدعم دون إعطاء الأخرى أية فرصة لتشرح وجهة نظرها، أو على الأقل قبل أن تتخذ الزميلات قرار الحكم على سلوكيات المشتكى عليها، وهن يعرفنها جيدا، وكان من المفترض أن يسألنها عما حدث لتسرد لهم الواقعة من جانبها، أليس هذا هو العدل؟! ولكن الذي حصل أن قصة المشتكية بدأت تدور في أروقة المكاتب والمشتكى عليها في غفلة من أمرها.
بقي الأمر فترة طويلة لم يُناقش، ولم يرُاجع مع الطرف الآخر، فقط تم الحكم لصالح من تقدمت بالشكوى أولا، إلى أن جاء يوم وخلال حديث عابر جرّ إلى حديث آخر وهكذا، وإذ بالمشتكى عليها تروي ما حدث في ذاك اليوم، المفارقة أن الأمر لم يكن مرتبا أو مقصودا، ولكن لسبب ما فتحت القضية، لقد كانت القصة التي قدمتها مختلفة تماما! كان ما ترويه يحمل بعض الحقيقة والواقعية لو أننا فكرنا فيه منطقيا، لا يعني هنا أن كل كلامها قد قلب المعادلة، ولكن على الأقل شكك بمصداقية ما وصل إلينا من قبل، ولكن للمرة الأولى وربما المائة بعد الألف تنبهنا إلى أننا تسرعنا في الحكم، وكيف أنه كان علينا أولا أن نسمع للجهتين قبل إطلاق أحكامنا واتخاذ قراراتنا، بالنسبة لي على الأقل شعرت بالخجل من أنه قد تم خداعي بسهولة لأنني سارعت في التعاطف واتخاذ الموقف، لأنني سمحت لنفسي بالانحياز إلى التي وصلت إلينا واشتكت. المقصد من كل ما سبق أننا لكي نكون أقرباء أو أصدقاء صالحين، يجب أن نقدر هذا ونكون على قدر من المسؤولية، وعدم التسرع حتى وإن كنا نعزّ بل نحب ونقدر من تقدم أولا بالشكوى، نعم نصغي، نعم نقدم الدعم المعنوي، ولكن المسؤولية تكمن هنا في أن نفكر من وجهة نظر الطرف الآخر ونحاول أن نبين للمشتكي ما يمكن أن يكون قد فاته بسبب ثورة الغضب أو حدة الألم، فعادة ما نقوم في هذه المواقف بإعادة ترتيب الحدث أو الأحداث كما نريد لها أن تكون أو كما يريد أن يراها عقلنا والذي حسب اعتقاده أنه تم التعدي عليه.
نحن هنا نتحول إلى معتدٍ، وأبعد ما نكون عن الصداقة أو القرابة إن لم نعطِ الأمر حقه من التقصي لمعرفة القصة كاملة وليس الحكم بعد الإصغاء من جهة واحدة، حتى وإن كنا نعلم جيدا نسبة مصداقية أو قوة حجج المشتكي، لكن إن لم نفعل ذلك فقد نكون ممن يصب النار على الزيت، وبدلا من المساعدة قد نكون نساهم في التدمير، الحلقة المفقودة التي قد تفوتنا دائما أننا نحكم بعواطفنا، بل هي أننا لا نحكم فقط بل ننحاز أيضا.
ما يجب أن نفعله هو التريث والتفكير، وعدم السماح لأنفسنا بالانجراف مع أي دوامة، لنبقَ خارجها ونتريث ونتقصّ، ثم نتدبر لنتحرك عن علم ودراية ونتأكد، قبل أن نظلم، ليس فقط المشتكى عليه بل أيضا المشتكي، كيف؟ بأننا لم نساعده على أن يرى الأمر بوضوح، ولم نساعده أيضًا في كثير من الأحيان على أن يكون هو الظالم وهو يعتقد بأنه المظلوم.
نعم، ليس كل من يصل إلينا أولا هو المظلوم ولا الظالم، الظالم هنا هو نحن حين نُفعّل المشاعر ونتركها تحكم وتأخذ جانبا ضد آخر تحت ضغط اللحظة والموقف، وليس هنالك نهاية أفضل لأختم بها هذه المقالة مما قاله رسول الله ﷺ: «انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا». فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلومًا، أفرأيت إذا كان ظالمًا كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.