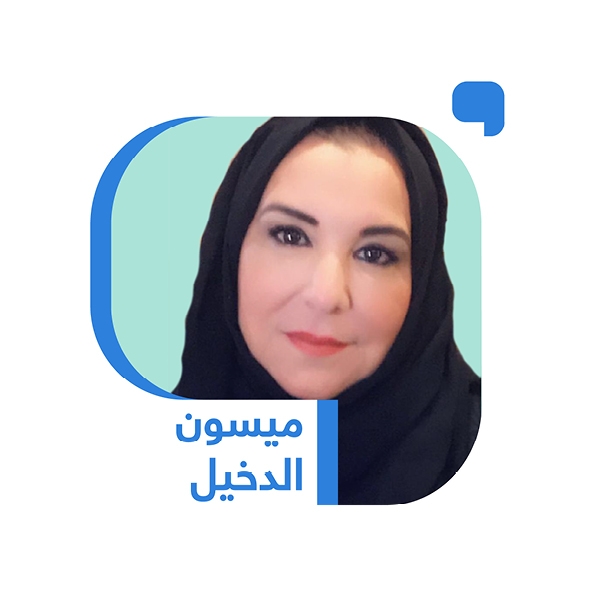سأحدثكم عن حادثة مررت بها، أضاءت بداخلي تساؤلات عن النفس البشرية، خاصة تلك التي تسكن كل منا، وبدلا من التصالح معها أصبحنا غرباء!
حدث مؤخرا خلال تواجدي في قاعة الانتطار الأرضية لمطارالأردن الشقيق، ونحن بانتظار رافعة لنقلنا إلى الطائرة بسبب أن الوالدة تستخدم المقعد المتحرك، كونها تجد صعوبة في استخدام سلم الطائرة؛ اقترب أحد موظفي المطار وهو يدفع مقعدا آخر لمراهق بقدم مجبرة، وعلى ما يبدو أنها كانت حديثة، أوقف المقعد بجانب الوالدة، وبما أنه لم يكن لدي شيء آخر يشغل بالي، أخذت أتأمله وأنا أتخيل الألم الذي يشعر به، فلقد كان شاحب الوجه، مشتتا، لأنه كان يحاول إخراج شيء ما من حقيبة يده، فوقعت على الأرض، فحاول أن يلتقطها ولم يستطع، قفزت من مكاني وناولته الحقيبة فابتسم وشكرني، هنا وجدتها فرصة وسألت: "حادث"؟ فأجاب بلغة إنجليزية ركيكة: "تزلج على الماء"، فالتقطت الكلمة وسألته: هل أنت بحاجة لشرب الماء؟ فابتسم وأجاب بالنفي ثم شكرني ثانية، انتهى حديثي والتفت إلى الوالدة لأرى إن كانت هي بحاجة لأي شيء، هنا علا صوت المذياع معلنا النداء الأخير للصعود إلى الطائرة المتجهة إلى "تل أبيب"، وما هي إلى دقائق حتى عاد الموظف ليجر الفتى، فسألته هل حان وقت رحلتنا، فأجاب: دوركم بعده، فسارعته بالسؤال ثانية: إلى أين؟ فرد بسرعة وهو يبتعد: تل أبيب! هنا شعرت وكأن أحدهم قذفني بجردل من الماء البارد في قلب عاصفة هوجاء! وأخذت كلماته الأخيرة تتردد في أذني كصدى قادم من مدى بعيد: تل أبيب.. تل أبيب! هذا يعني أنني حزنت وقمت بمساعدة "عدو".. تابع للكيان الصهيوني المغتصب! استرجعت كل ذاكرتي؛ الاعتداء، القتل، التشريد، الطرد، كل صور المجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني عادت حية أمام عينيّ.. واشتعل الغضب بداخلي، وسألت نفسي: "ماذا لو علمت حينها أنه كان العدو؟ هل كنت تحملت حتى النظر إليه؟ أصدقكم القول "لا أدري"، من كان سيتحرك بداخلي حينها؛ تاريخي وذاكرتي أم إنسانيتي!
لماذا ذكرت القصة بالرغم من أنها قد تفسر خطأ من كل من يحصر تفكيره داخل الصندوق فيركز على نقطة، ويرفض أن يرى الصورة كاملة من الخارج، الدرس هنا: ماذا يريد الله مني أن أتعلم من هذه الخبرة، ماذا يريد سبحانه أن أرى؟! بالطبع لا أستطيع أن ألغي عدائي للكيان الصهيوني وكل من ينتمي أو يتعامل معه، ولكن الدرس هنا كان يقتضي مني أن ألتفت إلى قومي وأدرس شيئا يجري بيننا هذه الأيام؛ إنها العداوة والهجوم والإقصاء، بل إنها حرب شنيعة على مدار الساعة نشنها بيننا، ليس كأمة بل كأفراد مجتمعات عربية الرابط بينها لا يقتصر على أرض وتاريخ واحد فقط، بل دماء واحدة سالت.. نسيناها كما نسينا لونها وجنسها ولم يبق منها سوى طعمها ورائحتها. أمر يدفعنا للهجوم الهمجي من أجل إسالتها من جديد وليس بأيدي أي عدو بل بأيدينا وبفضل سواعد أبنائنا!
هل أصبح طعم الدم إدمانا؟! لا نرتاح إلا إن مزقنا بعضنا البعض، ليس فقط بالأسلحة البيضاء وغير البيضاء، بل بمفردات أعظم لغة على الأرض، شوهنا لغتنا وشوهنا أرواحنا، بعدما كنا شعلة الثقافة والتمدن والحضارة، أصبحنا منارة الهمجية؛ بضع كلمات من هذا أو ذاك تحرضنا على الانقضاض على بعضنا البعض لننهش جسدنا العربي! ألا يكفيه جراح الأعداء لنزيده تمزقا وتشرذما؟ يا قوم وصل بنا الأمر إلى أكل لحوم البشر.. وحيا على الهواء مباشرة!
حين نقف (إنسان أمام إنسان) مجردين من كل ذاكرة تحمل أي تعصب أو كراهية أو حتى بغض، نتصرف بالفطرة التي فطرنا عليها سبحانه تعالى.. بمحبة، بعطف، برحمة، فلماذا لا نمسح كل الكراهية من ذاكرتنا.. نلغيها.. نعيد برمجمة أنفسنا، ونمد أيدينا لإخوتنا.. مهما كنا نختلف معهم، وإن سالت الدماء بيننا، أو حتى ولو أننا ظلمنا منهم، حسب اعتقادنا، أو حسب اعتقادهم ظلموا من قبلنا، لنتوقف في هذا الشهر الفضيل ونغسل قلوبنا بماء الفطرة التي أنعم علينا بها رب العالمين وكنا لها من الجاحدين، لنطهر جراحنا بالمحبة، بالتواصل، بالغفران والتسامح.. صعب؟ نعم، ولكن البديل أن نستمر بالقتل والعداء إلى ألا يبقى منا أحد!
إنها دعوة سلام في شهر السلام.. في الشهر الفضيل الذي نتقرب بأعمالنا فيه من عبادات إلى رب الكون.. رب البشر العظيم القادر على كل شيء.. رب كل البشر، المؤمن منهم والكافر، المذنب منهم والشريف، الظالم منهم والمظلوم، أفلا نجد في قلوبنا متسعا كي نسامح ونغفر لأمة واحدة من خلقه سبحانه! في هذا الشهر الفضيل ونحن نتعبد ونصلي، لنصلِ من أجل أن يساعدنا ربنا على احتضان إخوتنا، لنصلِ من أجل القدرة على المغفرة والتسامح، لنصلِ من أجل المحبة، لنصلِ من أجل أن تتطهر القلوب وتُغسل ذنوب الغير قبل ذنوبنا، لنصلِ من أجل أنفسنا، لنصلِ من أجل أن يجد جميع البشر طريقا أضعناه وكان يدعى يوما... سلاما.