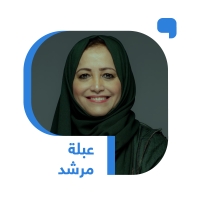يعدّ المشروع الوطني التنموي برنامجا متكاملا في مضمونه البنيوي والتنفيذي، والذي خلاله يمكننا تحقيق ما تتضمنه خططنا الخمسية، وما نستهدفه في برنامجنا التنموي من تحقيق رؤية 2030، في منجزات حقيقية تنعكس إيجابا على مجمل مقدراتنا الوطنية، وذلك يشمل مجمل البرامج والمبادرات الُملحقة ببرنامج الرؤية، وما يتصل بها من جهود وسياسات تشمل مختلف المؤسسات المعنية بالتنمية في الدولة سواء بمواردها البشرية أو الطبيعية.
ويمثل التعليم القاعدة التي خلالها يمكننا إعداد مواردنا البشرية المأمول إسهامها في بناء الصرح الوطني. فالتعليم مسؤول بصفة مباشرة وكبيرة عن تحقيق مشروعنا التنموي أكثر من غيره من القطاعات الأخرى، فهو مسؤول عن تموين سوق العمل بموارد بشرية متمكّنة في التخصصات المختلفة والمجالات المتعددة الحالية والمستجدة، وهو مكلف كذلك بتزويد سوق العمل بموارد بشرية مواطنة، ذات مستويات علمية متباينة يحتاجها سوق العمل بكل مؤهلاتها وقدراتها، وذلك يقتضي بالطبع توفير جميع الإمكانات المتطَلّبة للمؤسسات التعليمية العليا «ما بعد الثانوي»، لتمكينها من احتواء مخرجات الثانوية العامة، وتمثل الجامعات الحكومية المرتبة الأولى في الأهمية، لانتشارها في جميع المناطق ولمسؤولية الوزارة عنها، إضافة إلى مسؤوليتها في تيسير التحاق أبنائنا بالجامعات الأهلية المختلفة، بالابتعاث الداخلي أسوة بالابتعاث الخارجي. وتضاف إلى ذلك أهمية الارتقاء بجودة وتنوع تخصصات كليات المجتمع والكليات التقنية المختلفة التي تمنح دبلومات ما بعد الثانوي، وبذلك يكون دور وزارة التعليم فاعلا في استشعار المسؤولية للدور المطلوب منها في تمكين مواردنا البشرية من الإسهام في بناء الصرح الوطني وبأيد وطنية، وذلك يعدّ جوهر رؤية 2030، وبذلك تتحقق منجزاتنا وتطلعاتنا التنموية.
وبطبيعة الحال، إن توسيع إمكان القبول في الجامعات يتطلب بدوره مزيدا من الإنفاق وبسخاء على التعليم بصفة العموم، والتعليم العالي على وجه الخصوص، لما يقتضيه ذلك من الحاجة إلى مزيد من المقاعد الدراسية المتاحة، وإلى مزيد من أعضاء هيئة التدريس الذين تقوم عليهم العملية التعليمية، يضاف إليه جميع ما يتعلق بذلك من متطلبات توفير البنية التحتية، فيما يتعلق بزيادة المساحات المبنية، وما يتبعها من قاعات ومعامل ومنشآت داعمة للعملية التعليمية.
لا ننكر إننا نطالب بجودة التعليم كما نطالب بجودة مخرجات التعليم العالي، ولكن ذلك لا يرتبط فقط بقبول نسب مرتفعة من الدرجات للمتقدمين إلى الجامعات لتكون المخرجات مميزة، وإنما هو يرتبط كذلك بجودة التعليم ذاته والبيئة التعليمية، وغيرها من الإمكانات المتطَلّبة للجامعاتز
ومما يجدر التنويه إليه، أن ما يجري الآن من آلية لاحتساب الدرجات الموزونة للقبول في الجامعات، والتي تشكل فيها اختبارات قياس للقدرات والتحصيلي المطبّ الأكبر والأهم في إعاقة التحاق أبنائنا بالجامعات، لدورها الكبير في الهبوط بمستوى الطالب أو الطالبة بما يحول دون إمكان التحاقه بالجامعة، وليبقى ثروة بشرية مواطنة مهدرة من الاستفادة منها، خاصة في ظل تدني مستوى الدبلومات وتوقف الابتعاث الداخلي للجامعات الأهلية، ولذلك معايير ومتطلبات أخرى.
ولعله من الأمور البدهية والمطلوبة بقوة، أن تتواءم سياسات القطاعات المختلفة وإجراءاتها، وما تأخذ به من آليات، مع مضمون رؤيتنا الإستراتيجية وتطلعاتها التنموية الطموحة، وبما يسهم في ترجمة أهدافنا التنموية إلى منجزات فعلية نلمسها ونعيشها كوطن ومواطنين، وعليه لا بد أن تكون سياسات وزارة التعليم وما تُوجِه إليه من إجراءات وآليات، لما تحويه تحت مظلتها من مؤسسات تعليمية، تتفق مع توجهات الدولة وتطلعاتها الإستراتيجية والمتضمنة تأهيل مواردنا البشرية، وتمكينها من تحمل مسؤوليتها الوطنية كقيادات إدارية، وكموظفين مختلفي المهارات والتخصصات، يمثلون البنية التحتية لسوق العمل بقطاعيه.
ومن تلك السياسات المأمولة، التوجه نحو توفير مزيد من كوادرنا البشرية الوطنية، القادرة على إدارة مسؤوليات سوق العمل، والمشاركة في طبيعة أعماله المختلفة الراهنة والمستقبلية، وذلك يتطلب إجراءات موازية وملائمة لتنفيذ تلك السياسات تُترجم في: تمكين مؤسسات التعليم العالي والكليات المختلفة من زيادة نسبة المقبولين فيها خلال: التوجيه الوزاري لذلك، والدعم المباشر، والمتابعة الهادفة إلى تنفيذ ذلك التوسع المستهدف في الإمكانات المطلوب وجودها وتوفيرها في مؤسسات التعليم العالي بموارده البشرية والمادية، وعلى ذلك تُبنى الآليات في زيادة عدد المقبولين في الجامعات عامة والكليات المختلفة.
ومن جهة أخرى، فإن هناك سياسات وإجراءات تفصيلية لا بد من الأخذ بها في وزارة التعليم، وبما يتواءم مع ما نواجهه من تحديات وما نحتاجه من متطلبات تخصصية ومهنية لمواردنا البشرية، وعليه لا بد أن تتفق آلياتها مع ما نواجهه من عجز في مخرجاتنا السابقة كالطب والهندسة والقانون وجميع التخصصات الفاعلة والمهمة في سوق العمل الوطني، بما يقتضي زيادة نسبة القبول فيهم، وذلك يتم خلال خفض نسبة القبول المطلوبة فيهم، وتوفير كثير من المقاعد المضافة، ومزيد من الأعضاء لهيئة التدريس المطلوبة لذلك، وغير ذلك من المتطلبات التابعة.
ومما يجدر التنويه إليه، أن تلك الإجراءات لا تُعد مُستحدثة أو نشازا أو تعارضا مع الجودة في المخرجات لأسباب كثيرة يمكن اختزالها علميا ومنطقيا في: إن تلك الفجوة بين التعليم العام والعالي في مستوى التعليم، ووزن اختبارات قياس في ترجيح القبول وعدمه، وعدم الحاق السنة التحضيرية حتى الآن بالتعليم العام ما بعد الثانوي «ولذلك تفصيله»، جميع ذلك يقلل من فرصة تأهل أبنائنا إلى الجامعة، خاصة أن تلك المرحلة العمرية هي التي تتشكل فيها شخصياتهم، وتتضح طموحاتهم، وينضج تفكيرهم الذاتي، لرسم مستقبلهم وتحديد توجهاتهم.
أما على المستوى التجريبي، فإن تجارب الدول المتقدمة تقدم لنا نموذجا لذلك التغيير في السياسات والإجراءات، بما يخدم التحديات التنموية التي تواجه الدول، ومنها ألمانيا التي خفّضت لديها نسب القبول في كليات الطب لمواطنيها، وذلك منذ نحو 15 سنة، بعد أن وجدت أنها تضطر إلى استقدام كثير من الأطباء من الخارج لمواجهة حاجتها الوطنية، وعليه اتخذت ذلك الإجراء المستحدث بناء على الحاجات الوطنية المتطلبة، ولا يعني بالطبع ذلك الانخفاض في الجودة، لأن ذلك من شأنه أن يحفز الطالب على رفع مستواه العلمي وإلا سيلفظه التخصص، وكثيرا ما أثبتت التجارب العملية أن هناك كثيرا ممن تمكنوا إكمال تعليمهم في تلك التخصصات المميزة والصعبة بالابتعاث الخارجي وإلى جامعات مميزة، وذلك بعد أن حُرموا من القبول العادي أو القبول في تلك التخصصات في أوطانهم.
وإن ما نشهده من بطالة وتعطيل في توظيف مثل تلك الكفاءات الوطنية، التي تتعدى الآلاف من المواطنين وغيرهم من الكفاءات المختلفة، ليس حجة لرفع نسب القبول فيه للحد من نسبة المقبولين فيه، وليس هو نتيجة للتخمة في مخرجاتها أو تعميم تدني مستواها أو غير ذلك من المبررات المرفوضة، وإنما هو نتيجة خلل في السياسات والإجراءات المتصلة بالتعليم من جهة، وبسوق العمل ونظامه من جهة أخرى، وذلك يتصل بنظام التعليم، وبطبيعة المكون الهيكلي لسوق العمل ونظامه المؤسسي وموارده البشرية القائمة حاليا، والتي تنخفض فيها نسبة المواطنة إلى حد كبير، وإن استيعاب ذلك الواقع بشفافية وبصيرة، ومعالجته بالسياسات الصحيحة والإجراءات الملائمة المتناسقة، سيسهمان في تصحيح هيكل سوق العمل الوطني بجميع مكونه، كما سيعملان على تصويب واقعنا التنموي وتوجيهه نحو تحقيق رؤيتنا الإستراتيجية 2030، على أسس متينة راسخة، تستند على أيد وطنية تستهدف خير الوطن وازدهاره.