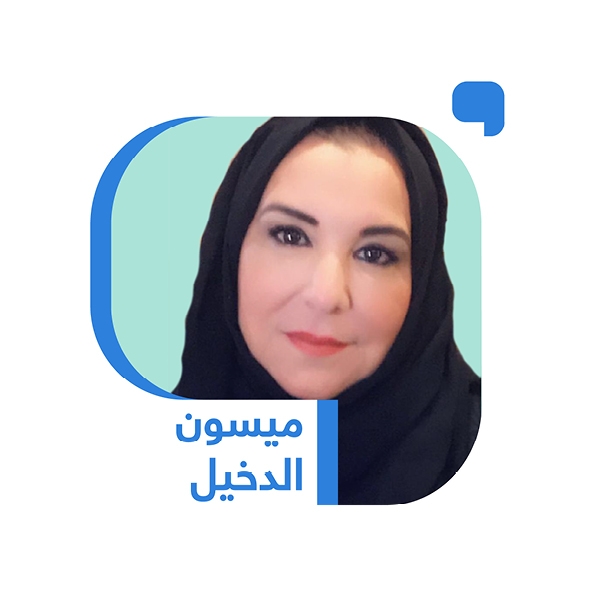أصبحنا اليوم نضع أيدينا على قلوبنا كلّما حضرنا حفل زفاف، لأن نسبة الطلاق ارتفعت، وما زالت آخذةً في الارتفاع.
وحين نتحدث إلى بعض هؤلاء الذين مرّوا بهذه التجارب المؤلمة، نجد أنه نشأ لديهم شعور بالإحباط، يصرفهم عن الارتباط مرّة أخرى!
بالطبع، الجميع يلوم الآخر على عدم التقدير، أو عدم الالتزام، أو عدم الشعور بالمسؤولية، أو عدم القدرة على المشاركة بالوقت أو بالجهد، أو حتى بالآمال والمشاعر!.
السؤال هنا: هل كل هذه السلبيات وُلدت معهم؟! لا بد أن للتنشئة دورا مهما في خلق هذه الأزمات في حياة الأبناء فيما بعد!.
لننظر إلى أنواع أولياء الأمور؛ هناك مَن يتابع عن بُعد تطوّر ونموّ أبنائه، يتدخّل فقط عندما يحتاج أبناؤه إلى المساعدة، أي أنه لا يتركهم يتعلمون من خبرات الفشل أو النجاح، بل يسارع في إزاحة العقبات كلّما ظهرت، ممّا يجعل منهم المراقب الصامت المتحرك. صامت لأنه لا يخلق أو لا يعرّض أبناءه لخبرات تعلّمهم طبيعة الحياة وتقلباتها، ولا يتركهم يواجهون هذه التحديات بأنفسهم كي يتعلّموا!.
وهنا، يتعوّد الأبناء على أن المساعدة دائما ما تأتي من خارج دائرة ذواتهم، وبدلا من التحرك والتفكير ينتظرون الانفراج!.
وهناك من يلتصق بأبنائه لدرجة أنه يقوم بكل الواجبات والمشاريع عنهم، كي يضمن لهم الدرجات العالية!.
وأما التعامل مع المعلمات والمعلمين في المدارس، فهو قصة أخرى.
إنهم يرون المعلم دائما على خطأ، وابنهم على صواب!
نعم، نصغي إلى أبنائنا لنعرف منهم ما حدث، ولكن أيضا نصغي إلى المعلم، ولا نعلن الحرب عليه، ونبدأ بالهجوم عليه قبل أن نقابله، لأن كل ما يسمعه منّا الأبناء يرسخ في دواخلهم، خاصة الطريقة التي نتحدث بها عن معلميهم، وبذلك ماذا يتعلم الأبناء؟ يتعلّمون أن الجدل وعدم الاحترام وحتى الصراخ سلوكيات عادية تستخدم في الحياة!، ويؤمنون بعد ذلك بأنهم دائما على حق، وأي شخص آخر يعترض حياتهم وقراراتهم سيكون على خطأ!.
ومن أولياء الأمور من يصبح ظلّا لابنه حتى بعد التخرج من المدرسة، ويحضر معه جلسات التوعية والتعريف في الجامعة، بل إنه لا يرى أي خطأ في مخاطبة أساتذة ابنه عن درجاته بدلا من ابنه، وحتى بعد أن يتخرج فإنّه لا يتركه يبحث عن الوظيفة بنفسه، بل يقوم بذلك نيابة عنه، وربما رافقه إلى المقابلة الشخصية، وهذا كله ماذا يخلق عند الابن؟
إنّ الأبناء الذين يرون أولياء أمورهم يحومون حولهم في كل خطوة يخطونها نحو المستقبل، هم أبناء ليست لديهم القدرة على التعامل مع العلاقات المختلفة في حياتهم. إنّهم أبناء محميّون من مواجهة أي ظروف صعبة، إلى درجة انعدام الثقة لديهم في قدراتهم الذاتية على تغلّب أي عقبات، وبالتالي فإنهم عند مواجهة ذلك في العلاقات الزوجية فيما بعد، يفشلون!.
ماذا فعلنا لتربية أبنائنا؟! هل أنشأنا جيلا قادرا على تحمل المسؤولية؟
إنّ ما فعلناه هو أننا خلقنا جيلا يتوقّع تلبية كل رغباته!، فنجد أن بعضهم كي يرتاح من الزنّ والاعتراض والمناقشة التي لا تعترف بكلمة «لا»، يرضخون لتلك الطلبات، أو إنْ كانت لديهم طلبات من أبنائهم فإنّهم يقومون بها بأنفسهم، حتى لا يعيشوا في قلق وانتظار لن يجديا!.
لا نعلّمهم تحمل المسؤولية؛ أي حين يتلفظون بشيء ما، يجب أن تؤخذ كلماتهم على محمل الجدّ، ويُعاملون على هذا الأساس!، ولكننا لا نحمّلهم مسؤولية كلمة أو وعد أو حتى أسلوب جارح أو خارج عن النطاق الاجتماعي، دائما ما نختلق لهم الأعذار، وربّما نعتذر عنهم؛ إنه صغير مثلا، مجرّد مراهق، جنون شباب، تعب، لا يدرك معنى ما يقوله بعد، مضغوط، إنسان طيب ولا يعني ما يقوله... إلخ!.
وإن حدث أي شيء من ذلك نحوهم قامت القيامة ولم تقعد، نبدأ بالهجوم الشّديد على المتسبّب! فكيف إذًا نتوقع أن تنشأ لديهم القدرة على التّعامل مع العلاقات فيما بعد في حياتهم، وهم لا يتحمّلون أي مسؤولية عن أفعالهم أو أقوالهم؟! ينشؤون على مقولة «أنا ومِن بعدي الطّوفان»!، إنْ لم ندرّبهم على توفير الوقت للإصغاء إلى احتياجات الآخر، والعمل على توفيرها أو على الأقل تفهمها، فكيف لأي علاقة مستقبلية أن تزدهر عندهم فيما بعد؟!.
العامل الأساسي هنا، هو التعوّد في بناء العلاقات على نكران الذات؛ بمعنى أن نفكر في ماذا يمكن أن نساعد الآخر حتى نستطيع أن نعيش في سلام معا، بدلا مِن: ماذا يمكن أن يفعله هذا الآخر من أجلي كي أعيش معه بسلام!
يجب أن ندرّبهم على التفكير فيما وراء أو أبعد من أنفسهم، حتى يمكنهم التعايش مع أي آخر بسلام.
فالزواج يتطلب الاحترام والمشاركة والتقدير والاعتراف باحتياجات الآخر، سواء كانت نفسية أو مهنية أو تطلعات وآمال. لا يوجد أحد يمكن أن يكون دائما على حق، ولكن خلال التفاهم والحوار وتبادل الآراء، وبتقديم بعض التنازلات تسير السفينة؛ وهذا لا يعني أن طرفا واحدا فقط يجب عليه أن يتنازل دائما، وأن طرفا واحدا يجب عليه الاعتذار دائما بغض عن النظر عمّن هو المخطئ! إن هناك أوقاتا نقوم بتحقيق رغبات الشريك ونحن لا نميل إليها، ولكن نقوم بها لمجرد أنها تُسعِد مَن نحبّ، ولهذا فهي تُسعِدنا، ولكن من المؤسف، ولكنه من المؤكد، أنه حين يتربى الأبناء في كنف أسر يتعامل فيها طرف بأنانية واستعلاء وتجبّر وتعالٍ على الطرف الآخر، فإنه يتولد لديهم نوع من الغطرسة أو الانكسار، ممّا قد يدمّر أي علاقة مستقبلية في حياتهم!.
نعم، في حياتنا اليوم نجد أن هناك من يأخذ وهناك من يعطي، ولا أعني هنا أنه يعيش ليعطي أو ليأخذ، ولكنها من سمات شخصيته، فالذي يعطي يدرك ماذا يريد؟ وماذا يحتاج؟ ولكنه يدرك أيضا احتياجات الآخر ويشارك، ليس لأن ذلك مفروض عليه، ولكن لأنه يشعر بالسعادة والارتياح حين يقوم بذلك.
أما الذي اعتاد أن يأخذ فقط، فلن يكتفي أبدا، وسيظل يبحث عن المزيد. لا يشعر بأي ضغط يفرضه على الآخر، المهم عنده أن طلباته مجابة، وقراراته أوامر دون أي اعتراض أو حتى تشاور! هل هذا بسبب جينات؟ أم إنهم ولدوا كذلك؟ بالطبع، إنها التنشئة، فإنهم لم يمنحوا الفرص لتذوق حلاوة العطاء والمشاركة، ويعتقدون أن العالم يدور حولهم لأنهم المركز!.
التربية ليست طعاما وشرابا ومأوى وتعليما فحسب، التربية تنشئة صحيحة على سلوكيات تواصلية واجتماعية سليمة، حتى يتمكن الأبناء فيما بعد من بناء أسر قوية وسعيدة، مبنية على علاقات حب واحترام وثقة وتشارك وإخلاص، وحين ننشئ جيلا أنانيّا يؤمن بأن ما يجري على غيره لا يجري عليه، فماذا نتوقع؟!