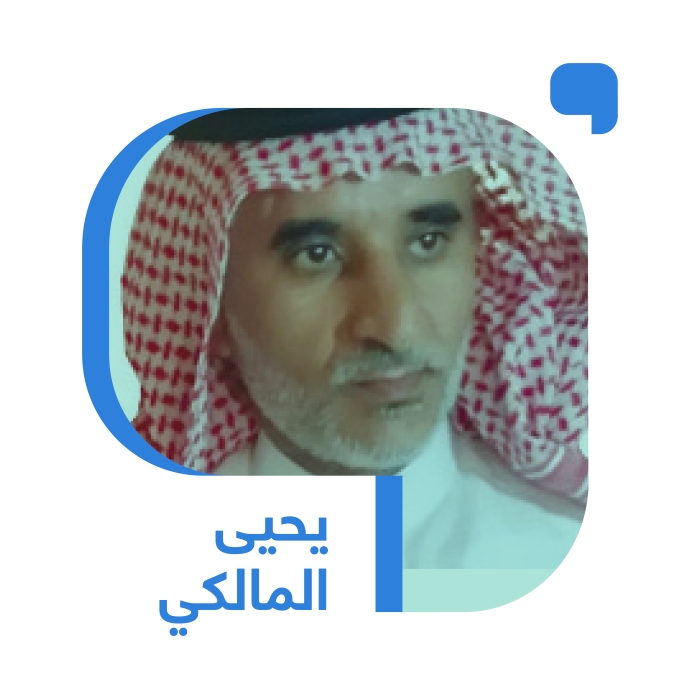الثقافة مفهوم واسع يشمل الإرث الحضاري الفكري والمادي لأي مجتمع، كاللغة والقيم والعادات والمثل والتقاليد والأفكار والمظاهر الشكلية والحرف المهنية والأدوات والمقتنيات، تتمايز وتختلف من أمة لأخرى ومن مجتمع لآخر في تفاصيلها الخاصة، وتلتقي مع بعضها في المشتركات الإنسانية.
وتسود الثقافة بحسب انتماء واعتزاز المجتمع الذي تنمو فيه، وتمسك أجياله اللاحقة بإرثهم الحضاري، وثقتهم واعتزازهم بما يمثله لهم من امتداد تاريخي وعمق إنساني يعزز هويتهم بين الثقافات المختلفة، وقد تصل بذلك حدود الهيمنة على بقية الثقافات، لأنّ سيادة الثقافة تعني قيادة الحضارة وقوة التأثير، أما ضعف الثقافة فيعني فقد الهوية، وغياب الدور الريادي. ولعلنا نتلمس أنفسنا وصولا لما نكنزه من هويتنا الثقافية، ونتفقد مخزوننا الحضاري لنتعرف على ما فقدناه من إرث ثقافي قد ندرك بعضه بجهود مخلصة تربط حاضرنا بماضينا، من خلال من تبقى من جيل الآباء والأجداد، فالثقافة تنمو وتتطور بتطور المجتمع، لكنها قد تتراجع بفعل العوامل المؤثرة ومن أبرزها قلة الاهتمام وضعف الارتباط بين الواقع الفكري والموروث الحضاري.
وإذا ما تحدثنا عن واقعنا الثقافي من جوانبه المختلفة فإننا سنجد على مساحات الجغرافيا الممتدة تنوعا ثقافيا واسعا، يؤثّر ويتأثر باختلاف الصلات التاريخية بين المجتمعات شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، ولكل ميزاته النسبية في مجموع التراث والثراء والعمق التاريخي والارتباط الوثيق بالماضي.
ومن جوانب الثقافة التي تبرز أمامنا باستمرار مظاهر اللبس - ونقصد به الشعبي على وجه الخصوص - وما يتعلق به من مقتنيات وتقاليد، وقد نما وتطور بالنمو الحضاري للإنسان في مجتمعنا، وهو بين قبول الجيل ورفضه، فمن يراه أصيلاً يميزه في مناسباته، وخصوصية يفتخر بها في ظهوره الاجتماعي، وعادة موروثة يتمسك بها لتروي حكاية أجداده، ومن يراه غير مقبول، فلا يتناسب مع النسق الحضاري – من وجهة نظره – ولم يعد المذيّل، والمصنف والوزرة والحوك والسدرة والمدرعة، لائقا في عصر الموضة المتجددة والعولمة المنفتحة، وليس ذا أهمية في المدلول الثقافي والموروث الحضاري.
وفي ظل التقنيات الحديثة ودورها المؤثر في نقل الثقافات، ضلّ كثيرٌ من أبنائنا طريقهم في انتقاء المظاهر اللائقة، باختيار التقاليد التي لا تمثل إرثهم، بل تخالف موروثهم، على سبيل الإعجاب بالمشاهير في مجالات كرة القدم والإعلام والمسلسلات، فأصبحت مظاهر التقليعات والنقوش والقصّات المتعددة والتعليقات والأسورة والموضات الخارجة عن الذوق أمرا مألوفا يتنافسون فيه على مستوى الشباب والشابات، ولم يقف ذلك التأثير عند حدود المقتنيات الشخصية، فقد أزاحت تلك الثقافات المقلّدة الكثير من المظاهر الاجتماعية في مناسباتنا – كالأعراس مثلاً – بما آلت إليه من طقوس وزفّات ونقوش تخلصت من محتوى التقاليد، وانسلخت من الأعراف الأصيلة التي كنا نراها في لبس الجدّة وحناء يدها وملاحة العصائب على رأسها والوضح في يدها وأعلاج الفضة على صدغيها وكحل الحجر في عينيها، وخروج النساء في صف زفافها بصفائق الحرير وقطائف النّعمان، على خلاف ما نراه اليوم في زفاف بناتنا على طريقة (ماريا) أو(لميس)، وحتى الأسماء غابت عن الأصالة ودارت في فلك الغريب ومحيط (فانكا).
أما على المستوى الفكري فيظهر لنا جليّاً مدى الانصهار في الثقافات الدخيلة المستوردة، فعلى صعيد اللغة تبرز لنا اللُّكنُ الاستعراضية بدءا من (هاي) إلى ما لا نهاية، وتضمحل الذائقة الأصيلة في أحضان (البوب) و(الديسكو) ومعزوفات جاكسون، وجملة من القوائم والأسماء ليس من خياراتها العرضة أو الزامل والعزاوي ولا الطرق والخطوة.
ولم تعد مقتنياتنا وأدواتنا التراثية لدى الكثير من أجيالنا الحاضرة معروفة الخاصية والاستخدام، فهي تعيش في المتاحف غربة البقاء، لا تمثل سوى تحف فنية لا فرق بين أداة الحرث والحرب عند من لم يتعرف عليها.
ويتحمل الجزء الأكبر من هذا الفقد الثقافي والفجوة العميقة بين الواقع والموروث الحضاري جيل الآباء ومن سبقهم، لعجزهم عن ربط أبنائهم بماضيهم، وقد أتى زمن تخلصوا فيه من موجوداتهم وأدواتهم واستغنوا عنها بما وفرته الحضارة المادية التي أفرزتها الثورة الصناعية الحديثة، والتي سرقت الأضواء من تراثهم فبددوه وأهملوه، فانقطعت الصلة بينه وبين الأبناء والأحفاد، فأصبح حجم المفقود كبيرا.
وبين الأمس واليوم موروث ثقافي غاب جلّه في وحل الدخيل، وذابت مفرداته في محرقة التقليد.
فهل ستدرك جمعيات الثقافة والفنون والأندية الأدبية وغيرها شيئا مما فات؟ ولا زالت قنواته متاحة بما تبقي لنا من الأجيال السابقة، لتحيي فينا روح الموروث، وترصد لأبنائنا جوائز محفزة، وتشجيعات مغرية، وإن كانت هيئة الترفيه هي أحد منابرنا المهمة التي نؤمل فيها الكثير بإحياء موروثنا الثقافي في نفوسنا، التي تتوق لعودته في نسق يتلاءم مع روح العصر ومعطياته.