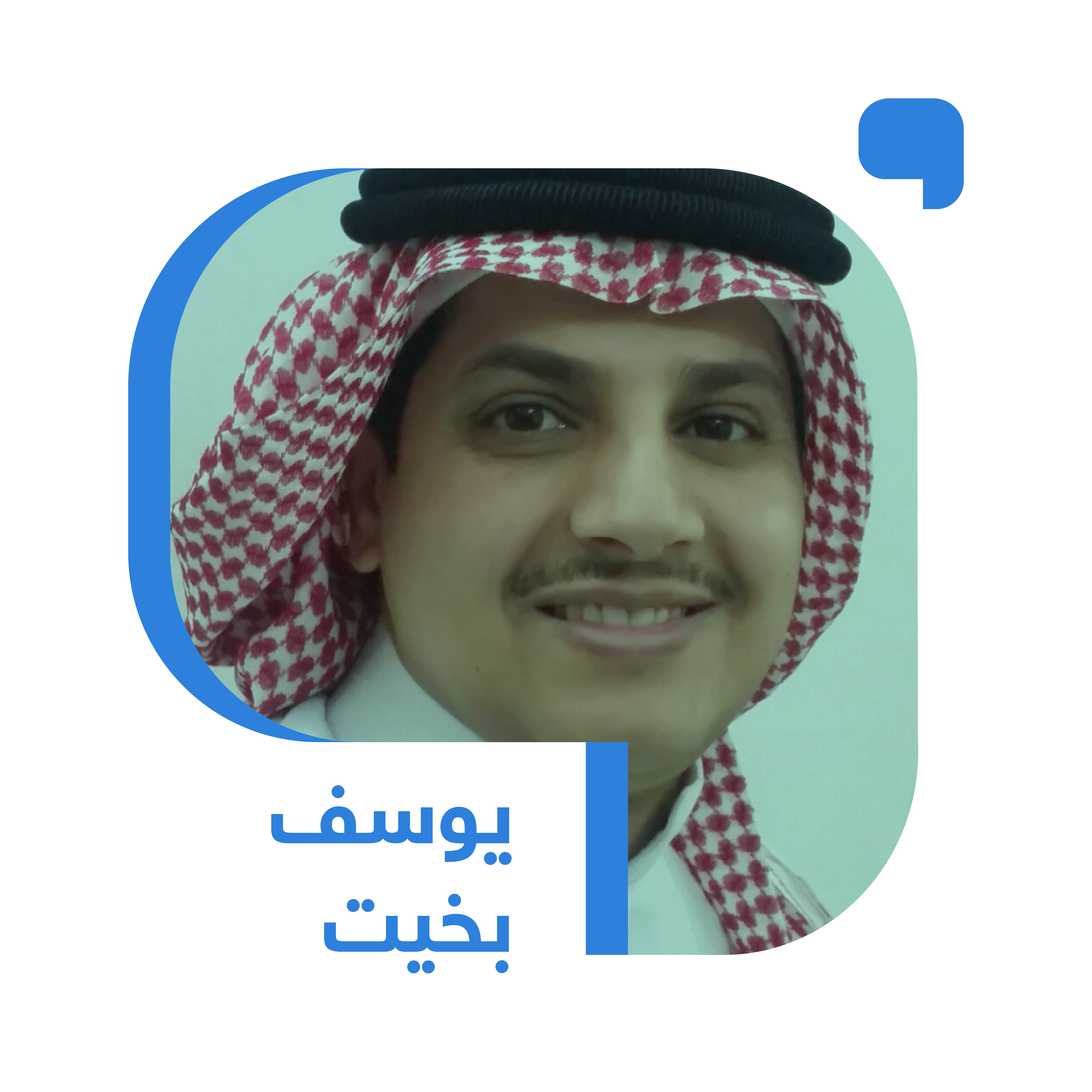إن الإنسان يخشى مما يأتي به الغد من شرور، فيبذل جهده ليأتي هذا الغد مشرقا، وهو في حال قوية من الصحة وتحصيل الأمن والمسكن والغذاء، وفي أحوال كثيرة لا يبالي بما يبذل من تعب في سبيل تحقيق وتأمين حاجاته الضرورية، يركض في دروب الرزق والعمل، وكلما حصّل نجاحا صار حريصا على المحافظة عليه، وإضافة نجاحات متتالية إليه، والخوف من الخسارة هو الدافع الكبير وراء جميع ما سبق.
ما يمكن تسميته بالخوف المتزن، لا ضرر منه على صاحبه، بل يُعدّ وجوده ضرورة تحمي من التهور في الأقوال والأفعال، وتقي من الانزلاق إلى دروب الهلاك وما لا تُحمد عاقبته، وتخيّلوا شخصا لا يعرف الخوف والحذر إلى قلبه سبيلا، سنرى فردا متهورا طائشا، يؤذي القريب والبعيد، بل يسبب لنفسه ضررا مستمرا، فلا يخرج من مأزق إلا ويقع في آخر، وقد يسلم أكثر من مرة، ثم تأتي ضربة قاضية، يجرها على نفسه، تضعه في ورطة لا يستطيع لها حلا، وهو من كان في يوم من الأيام يزعم أنه الشجاع الذي لا يعترف بالخوف، ويرمي من له نصيب من الخوف بالجبن والتردد.
ربما يتحول الخوف الزائد إلى نوع من الوسواس في الصدر، فالأب يمنع ابنه من تحقيق رغبته في الدراسة أو العمل، للخوف من عدم نجاحه فيما اختار، والصواب أن يجلس معه جلسة نقاش أبويّ، ويبدأ في الاستماع إلى وجهة نظر ابنه كاملة، ثم يتأكد من استيعابه ما سمع، وبعدها يقول رأيه بوضوح ومحبة، ويعين الابن على الاختيار الصحيح، والحال لا يختلف كثيرا مع الأم التي أودع الله في قلبها الخوف ممزوجا بالرحمة، وهذه صفة مشتركة بينها وبين الأب، إلا أن زيادة الخوف على أبنائها وبناتها تقف حائلا بينهم وبين ممارسة حياتهم الطبيعية، ويضعهم داخل قفص من التسلط والريبة بزعم الخوف عليهم.
لا شيء يقتل الفرح مثل الخوف من سوء عاقبة الفرح، وهي ثقافة غريبة تنتشر بين الناس، وأخشى أن أقول تنتشر بين أكثرهم، ولا شك أن أحدنا ضحك يوما ضحكا عميقا في رحلة أو سهرة طالت مع الأقارب والأصدقاء، وفاض القلبُ خلالها بالسعادة النقية، وإذا بصوت نشاز لأحد الحاضرين يرتفع قائلا: الله يعطينا خير هذا الضحك، وكأن الضحك والانشراح، في رأي الأخ المتوجّس، إنذار مبكر لقدوم عاصفة من الحزن.
وواضح أن نشأة فكرة غريبة كهذه الفكرة المتشائمة وغير المنطقية، عائدٌ إلى الخوف المبالغ فيه حتى من لحظة سعادة، وعجبا لنا كيف نسمح لبقع الأفكار السوداء بتلويث المساحة البيضاء الكبيرة الجميلة للفرح.
في زمنٍ انقضى بأهله وظروفه، قال المتنبي مكتئبا ليلة أحد الأعياد:
عيدٌ بأيّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ
بمَا مَضَى أَمْ بأمْرٍ فيكَ تجْديدُ؟
أمّا الأحِبّةُ فالبَيْداءُ دُونَهُمُ
فَلَيتَ دونَكَ بِيداً دُونَهَا بِيْدُ
ومنذ ذاك الحين يتخذ السوداويون مطلع هذه القصيدة شعارا وحُجة للهرب من فرحة العيد، ومخرجا للتنصّل من رسم الابتسامة على وجوههم، ومن نافلة القول إنها حجة واهية البنيان متداعية الأركان، ومخرج وهمي إلى طريق مسدود، وإذا كانت الرغبة في الفرح جادة، فهناك ألف سبب للفرح، ويكفينا سببا ما حبانا الرحمن وأحاطنا من جزيل العطايا وكثير النعم، في حين يتمنى آخرون بعض هذه النعم التي اعتدنا وجودها في حياتنا.
يا رفيق الحرف، إن كنت تخشى أن يحدث لك مكروه لأنك ترتدي ثياب الفرح، وتكتسي منها سابغ الحُلل؛ فأنت مخطئ فيما تخشاه، وواهم فيما تزيّنه لك أفكارك، واحذر أن تجعلك فوبيا الفرح تمشي بين الناس بأسمال الكآبة وسرابيل الحزن، ولو فقدتَ عزيزا بالموت أو البعد فهذه أقدار تجري على بني آدم جميعا، وعليك استيعاب مفهوم الموت والفراق، والتعايش مع فكرة أن الراحل لن يعود إلى الحياة، وحزن القلب عليه ليس حائلا بينك وبين أفراحك، وما زالت لديك حياة تستحق منك الفرح، وأيام جديرة بسكب السعادة في أوعيتها، أما إذا امتلأت أوعية أيامك بثقوب التشاؤم والخوف، فلا تُفاجَأ بحصيلتك الصِّفرية من السعادة.