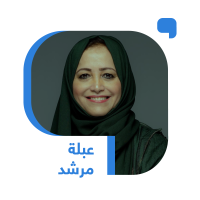نعيش الحياة في خضم منظومتها المليئة بالقضايا والأحداث المختلفة، تتواتر علينا واجباتها ومتطلباتها العامة والخاصة، الأساسية والكمالية، ويختلط فيها الصالح بالطالح من المسؤوليات والواجبات، منها ما يستحق ما نبذله من جهود فيثمر طرحه، ومنها ما لا يستحق ما تستنزفه منّا فيكون هدرًا ضائعاً وهباءً منثوراً، وهكذا تستمر دوامة الحياة بعجلتها الدائرة، وبنهجها المعتاد، لتطوي الأيام والسنون من أعمارنا، ونحن نتابع تحقيق تطلعاتنا، ونسعى نحو ملامسة آمالنا لنعيشها حقيقة، دون الالتفات بُرهة إلى الخلف، لمراجعة بعض سلوكياتنا وتقييم شيء من أدائنا، لترتيب حياتنا نحو الأفضل، حتى يفاجئنا القدر بمحنة أو أزمة أو أكثر، فتكون هي المحكّ الذي تُكشف فيه الأوراق، والمختبر الذي تحُلل فيه الجهود، بل والمفتش الإجباري لجميع المقتنيات الخاصة والعامة، ليطفو الصالح منها على السطح، ويندثر الطالح إلى القاع، فالمحن هي المصباح الذي يضيء لنا الطريق نحو الجادة الصحيحة، وهي المنبه الكوني لمراجعة حساباتنا بمختلف مستوياتها.
قد تكون المحن والأزمات بسيطة، وقد تكون كبيرة، وقد تكون عابرة وسريعة، وقد تكون مقيمة ومستوطنة، وذلك يحصل على مستوى الأفراد والجماعات والأوطان، وعلى الرغم من اختلاف درجة تأثيرها وعمقها، إلا أنها لا بد أن تترك بصماتها، فيكون عمق البصمات ووضوحها وقوة تأثيرها، بحجم الاستعداد لمواجهتها واستقبالها، فمتى كان الاستعداد قويا والأرضية متينة، فإن الأزمات والمحن تزيدها صلابة وقوة، فتُكتشف خلالها ثغرات الوهن، وتُرصد مكامن القوة الداعمة والمساندة لمواجهتها، وعلى النقيض منه، إذا كانت الأرضية هشة، فإنها سرعان ما تتحطم ويهوي البنيان الشامخ، ليكشف عن وهن داخلي ومقاومة مزيفة، تحتاج إلى إعادة البناء على أسس قوية وقواعد صلبة.
اقتحمت كورونا مجتمعنا البشري دون استئذان، وطال أذاها معظم البلدان، وحصدت من الأرواح ما شاء الله لها أن تأخذ، وتعافى من وبائها من كتب الله له عمرا آخر، فكسدت على أثرها الأسواق، وتعطلت بسببها الأعمال، وفرضت علينا -قسرا- نوعاً من الحياة ونمطاً من المعيشة، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا، فهل نتّعظ ونتدبر؟! وهل نستفيد من تجارب ومحن كهذه، لمراجعة بعض سياساتنا وإجراءاتنا، ولنقِّيم حجم ونوع استعدادنا لها ولغيرها مما يخفيه لنا القدر؟! وهل نخرج من تلك المحنة برؤية جديدة ومعايير مؤسسية ووطنية، تنطلق من واقع وأحداث عشنا تفاصيلها، ولمسنا مستوى التفاعل معها؟!
وهل نُعيد تقييمنا لأنفسنا كوطن وكمقدرات بين الأوطان؟! وهل تميزنا عن غيرنا في جوانب وأخفقنا في أخرى؟! وهل وهل؟!
بالطبع، ذلك التقييم والمراجعة، لا بد أن يشمل جميع المستويات الوطنية، سواء المجتمعية منها أم الفردية والمؤسسية، بل وحتى الإقليمية والدولية، لكونها محنة لامست جميع المكونات الاجتماعية، باختلاف مسؤولياتها، ليتحمل كل منّا دوره في التقييم والتصحيح، سواء في أسلوب العلاقات الأسرية بين أفراد الأسرة الواحدة، أو في أسلوب إدارتنا لمؤسساتنا الوطنية، ومستوى مشاركتها وقدرتها على تحمل مسؤوليتها الوطنية التي تكشفها الأزمات، أو على مستوى العلاقات الإقليمية مع دول الجوار الشقيقة، قبل تلك التي تنتهك القوانين الدولية، أو على مستوى علاقاتنا الدولية لنعيد تقييم وزننا وحقيقة مكاننا بين دول العالم المتقدم، الذي ما زال يتصدر قائمة الإنتاج العلمي والصناعي، رغم ضعف بعضه في إدارة الأزمات المفاجئة والمحن العالمية، ليكون لنا في ذلك عِبرة، وليوقظنا من قناعات كانت راسخة لدينا، لنبدلها بأخرى متجددة تعزز من ثقتنا في مقدراتنا.
على المستوى الأسري، كشفت لنا المحنة وذكّرتنا بأهمية التقارب بين أفراد الأسرة، والتشارك في حل الأزمات، والاستفادة من تجارب بعضنا البعض، بما يقوّي روح التكاتف والتعاضد في معالجة مختلف إشكالات الحياة.
أما على المستوى الوطني، والذي يشكل محور نقاشنا، فإن التقييم فيه يتشعّب نحو عدة مسارات مختلفة، تستظل جميعها تحت راية الوطن، منها ما يرتبط بالجانب المجتمعي للأفراد وسلوكياتهم، ودرجة وعيهم ومستوى ثقافتهم، وحجم تفاعلهم ومستوى مواطنتهم، ليتم رصده ودراسته علميا، للخروج بآليات تسهم في تعزيز مرتكزاته القوية، كما تدعم سد ثغراته المختلفة، التي قد تسهم في تبديد الجهود الوطنية المبذولة.
أما على المستوى المؤسسي، فقد كشفت لنا الأزمة -كذلك- مستوى عاليا من الجديّة والمهنية المطلوبة في إدارة الأزمات الوطنية، وفي احتواء الكوارث المفاجئة والتحديات الطارئة، وذلك على مستوى القيادة الرائدة في نهجها، والمؤسسات المعنية بمسؤولياتها، والتي سجلت فيها وزارة الصحة بمنسوبيها من المواطنين، عملا ميدانيا وإداريا مشرِّفا يُحسب لها، ليس على مستوى الوطن وإنما على مستوى العالم، في ذلك الاستيعاب المبكر لحجم المحنة وتبعاتها، وآلية التفاعل معها بمستوى عالٍ من الحرفية في الأداء المهني والمؤسسي، والذي يستحق الوقوف عنده ليس للتأمل والتقدير والاعتزاز فقط، وإنما للاعتراف والتأكيد بأن المواطن هو دعامة الوطن، وهو وسيلته وأداته المأمونة، وهو درعه الواقي في معالجة الأزمات، للخروج من الكوارث بأقل الأضرار، وأفضل النتائج المحسوبة.
لا نبالغ في تقدير جهودنا وسياستنا نحو احتواء الأزمة الوبائية، ولكن لا بد أن نناقش ذلك بشفافية عالية ومهنية محترفة وحكمة، تُمكّننا من تعزيز قدراتنا وإمكاناتنا في مرتكزاتنا القوية، وتُسهم في اكتشاف ثغراتنا الداخلية على مستوى المؤسسات والأفراد ودرجة المواطنة، لنسارع في ردمها وتصحيح مسارها واحتوائها، نحو التميز والإبداع، ليكون الإنجاز في أبهى صوره.
أثبتت لنا المحنة أن المواطن هو من يرتكز عليه الوطن في إدارة الأزمات والمحن الوطنية جميعها، وأن المواطن الكفُؤ يستحق التقدير، وأن المواطن يستحق أن يأخذ مكانه اللائق في وطنه، فهو عدة الوطن وسلاحه الآمن والدائم، فبالمواطنين تزدهر الأوطان وتعلو رايتها، وصدق المثل الشعبي في قوله: «ما حك جلدك مثل ظفرك»، و«أهلك لا تهلك!»، ويقال كذلك: «أهلك هم أهلك ولو صرت على المهلك».