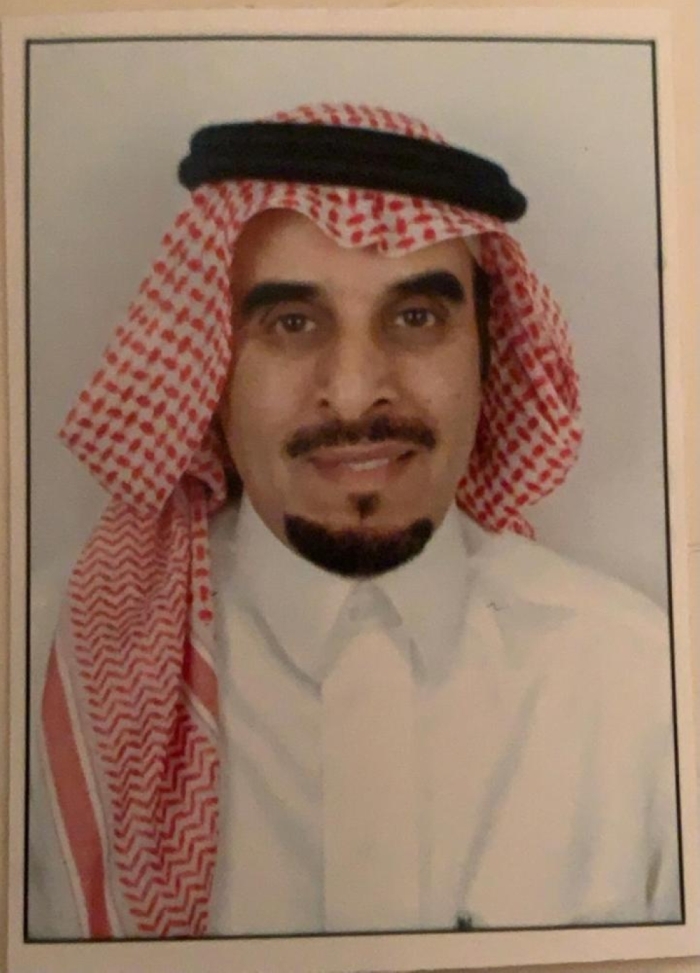والإنسان بطبعه يطمع إلى المزيد من السرعة في حياته بدليل المتابعين الكثر لأخبار أبحاث العلماء في مجال السرعة بداية من نظرية أينشتاين «النسبية» التي عارضها الكثير وقتها، حين أضاف بعدًا رابعًا وهو «الزمن» على الأبعاد الرئيسة المعروفة الطول والعرض والارتفاع ومعادلاتها الرياضية حول سرعة الضوء، وصولا إلى تقنية «النانو» بخصائصها الفيزيائية والكيميائية ذات الجزيئات الصغيرة غير العادية التي ظهرت قبل أربعة عقود.
وأدرك العلماء أهمية السرعة لمستقبل النقل كمطلب ملح من المجتمعات البشرية، فأخذوا يركزون أبحاثهم في هذا المجال، وكمثال على ذلك فكرة السفر البري عبر كبسولة «الهايبر لوب» بسرعة الرصاصة، إضافة إلى توقع ناسا الشهر الماضي أن يستغرق وصول البشر إلى الكوكب الأحمر «المريخ» في خمسمائة يوم، وجاءت المفاجآت من مركز أبحاث آخر أنهم طوروا مركبة تقطع المسافة في أربعة وخمسين يومًا، بواسطة الدفع الحراري لليزر وتوصيل الطاقة للمصفوفات الكهربائية على مركبة فضائية ليتم الدفع إلى الأعلى.
وهذا يعني أن السرعة أصبحت القاسم المشترك في المشهد الحضاري العام بعوالمه الافتراضية، وأن القادم الجديد «الميتافيرس» بدأ يلوح في الأفق، وفي عالم الأطفال لاحظ معلمون وآباء انجذابهم نحو السرعة المتوفرة في أغلب الألعاب الإلكترونية، وتأثيرها على ممارساتهم في الأكل واللعب وكثرة الحركة والتوتر.
من الطبيعي حين اختار أو وجد إنسان هذا العصر السرعة والتسارع والعجلة أسلوب حياة ترتب عليها ارتفاع حالات القلق والاكتئاب والغضب والغلظة في القول والإساءة في التعامل وعدم التركيز، كما أن التأخير البسيط والتأجيل أمر وارد في أي ظرف إلا أنه يُصنف في نظرهم من الأخطاء التي لا تُغتفر ويتلاشى معها الصبر والآناة والحلم.
السؤال الذي يبحث عن إجابة واضحة.. هل حققت تلك الإنجازات العلمية في السرعة متطلبات الإنسان وأشبعت غروره؟ أم أنه لا زال يطلب المزيد منها؟ وما علم أن عمره أسرع وأقصر من ذلك كله.. فلله الأمر من قبل ومن بعد.