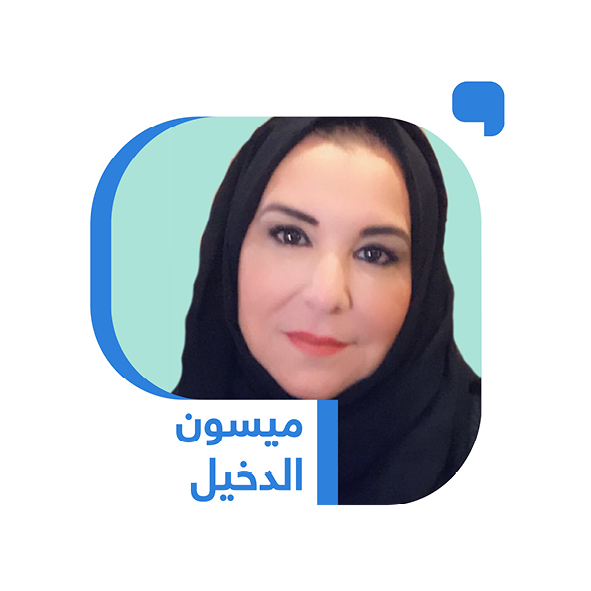نعم إنه عصر المعلومات وقوة المعلومة، نعم إنه عصر تسليط الضوء على القضايا التي تستحق التركيز والمتابعة لكشف الفساد وعدم الأمانة أو الاحتيال أو إساءة الاستخدام مما قد يمر دون أن يلاحظ أو يتم تجاهله أو التعتيم عليه، ولكن هذا فيما يخص قضايا محورية تهم المجتمع ككل، والانتباه إليها ومعالجتها يعود بالفائدة على أفراده، ولكن... ما يحدث هو أن الحابل اختلط بالنابل لمجرد دخول الكثيرين على الخط ممن لا يرتكزون على علم أو خبرة واختصاص ليتصدروا المشهد ويفرضون آراءهم وبالتالي يشتتون العامة من الناس!
نتخلى عن المسؤولية في التأكد والتمحيص ونقذف الكرة في ملعب الناشر أو المتحدث! ولسان الحال يقول: «هي قالت، هو أفتى، هذا حلل، وذاك نشر»! القيل والقال تشدنا أكثر ممن قال ومن أين حصل على المعلومة، وما هي مرجعيته، وهل تهمني، أو هل الأمر من شأني ويحق لي الاطلاع عليه؟!
نحن لسنا مطالبين أخلاقيًا بألاّ نكذب وألاّ نشوّه الحقائق فقط، بل نحن مطالبون أيضًا بأن نبتعد عن الأكاذيب وكل من يروج لها، وهذا يعني أن نكون حذرين ويقظين ليس فقط فيما نكتبه، ولكن أيضا في كيفية معالجة ما نقرؤه وما نتناقله على أنه حقائق.
ليس أسهل من الرجوع إلى المصادر الموثقة ذات المرجعية الرسمية، لكنه الكسل واستسهال الانقياد بدلا من القيادة! إن القدرة على الوصول إلى المعلومات تضعنا أمام مسؤولية تفعيل التفكير الناقد، لطرح أسئلة مهمة تحمينا من التضليل وتمنحنا القدرة على التوصل إلى الحكم السليم قدر الإمكان. فإذا كنت تريد أن تعرف أكثر عن المتحدث فالأمر لا يحتاج أكثر من رحلة إلى موقعه الرسمي ومطالعة ما وضعه من معلومات موثقة عن تخصصه وخبراته، قبل أن تقرأ ما كتبه من معلومات أو أخبار؛ بمعنى يجب أن نسأل أنفسنا؛ من هو الكاتب أو المتحدث صاحب هذا الفكر أو هذه الكلمات؟ ما هي السلطة المعرفية أو مستوى المصداقية التي يمتلكها؟ كيف يتطابق ما يقوله مع ما أعرفه عن الشخص أو المكان أو القضية قيد النقاش؟ هل هناك جانب آخر لهذه القصة؟ هل لدي كل الحقائق والمعلومات لأصل إلى نتيجة موضوعية وصحيحة؟
القضية ليست من هو أكثر شعبية أو من هي أكثر إثارة، القضية هي حقائق ودقة، فلا نترك المجال لأي شخص أن ينشر أفكاره وآراءه وحتى نسخته من الحقائق دون أي مرجعية متخصصة، دون أي مساءلة أو مواجهة العواقب. لقد أصبح الكل خبيرًا، بل ويدخل الفرد منهم في النقاشات بكل ثقة مطالبا بالمساواة الفكرية وأن يتم التعامل مع ما يطرحه بنفس أهمية ما يتم طرحه من قبل المختصين والخبراء، وإن طالبت بمرجعيته وخلفيته المتخصصة، اتهمك بالنرجسية والتعالي!
نعم من حق كل امرئ أن يبدي رأيه، ولكن في المسائل التخصصية يجب أن يكون هذا الشخص ذا مرجعية علمية، كما أنه يجب أن يعرف تماما أبعاد وحيثيات الموضوع أو القضية، غير ذلك يصبح يشكل خطرًا على سير الحقائق ويشتت الموضوع وقد يعرض آخرين للخطر مثل الضياع أو السقوط، خاصة إذا ما كان من أصحاب الأتباع والتأثير على فكر الشباب وتوجهاتهم.
وماذا عن أخبار الناس، التي تصلنا يوميا بشتى وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت؟ فهل هو شأني لماذا تم طلاق فلانة، أو تسريح فلان من العمل؟ من سقط ومن وقف ومن اختفى ومن ظهر؟ حتى وإن كانت وصلتني المعلومة صحيحة، ليس من حقي أن أنشرها، بل ليس من شأني أن أتابعها! أما إذا كنت ممن لا يرتاح حتى يحصل على المعلومة عن كل ما هو غامض أو ليس معروفًا عن حياة الناس، هنا يكون الأمر عبارة عن خلل في تركيبة شخصيتي النفسية يجب أن أعالج منها، وإلا سوف أتسبب بأذية ذاتي قبل أذية غيري من أصحاب العلاقة! لأن الأمر هو عبارة عن جوع لا يمكن إشباعه وبهذا أقضي وقتي في متابعة أخبار الناس والعيش في قلق دائم من أن تفوتني أي معلومة يمكن أن أستعرض بها أمام الغير وأظهر بأنني «أبو العريف»! المشكلة أن هؤلاء الناس إن لم يجدوا ما يتداولونه عبر الأثير، اخترعوا القصص أو قاموا بتضخيم ما بين أيديهم أو إعادة تدويره حتى ولو بعد زمن، لأنهم إن لم يتمكنوا من ذلك أصيبوا بانهيار لسبب بسيط ألا وهو أنه سوف تتضح لهم ضآلة مكانتهم وسطحية فكرهم وانعدام إنجازاتهم، ويبدأ الاحتراق من الداخل، وعليه يصبح الأمر بالنسبة إليهم: «ليحترق غيري وأبقى أنا»!
إن الإنترنت كما هو مصدر ثري للمعلومات ونعمة في حياتنا، هو أيضًا حمل أخلاقي وفكري يجب أن نلتزم به، فالعبء يقع على عاتقنا أن نظل يقظين حتى لا نفترض أن كل ما نقرؤه صحيح، أو نتابع أخبار الغير الخاصة؛ وإن كانت صحيحة، لمجرد أنها متاحة.