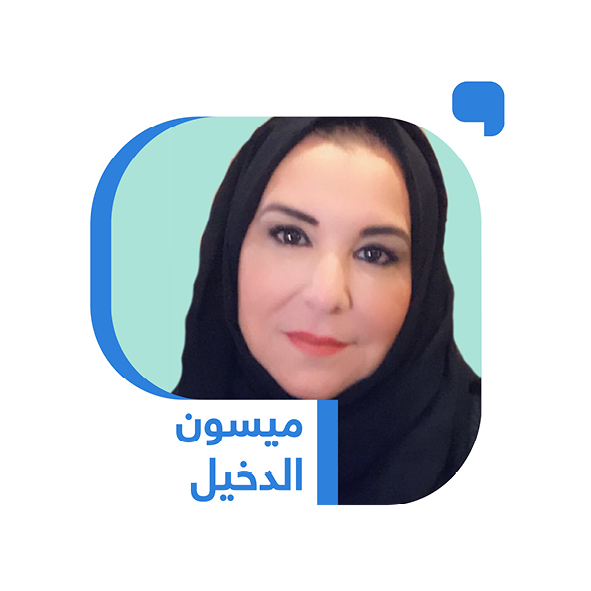والآن لنتأمل سويا المشهد التالي:
حلقة حوار يناقش فيها رجل من الحضور ضيوف الحلقة حول حقوق المتحولين جنسيًا في توفير الفوط الصحية في المدارس!.
الضيفة: إنه فعلا أمر مزعج أن يحرم المتحولون جنسيًا توفير الفوط الصحية في مراحيض المدارس!. (لها حق أن تنزعج، فهي امرأة متمدنة تؤمن بالمعنى الحديث لحركة «استيقظ» (WOKE) التي توسع معناها في العقد الأخير «من التنبيه إلى التحيز العنصري والتمييز»، الذي كان يستخدم خاصة من قِبل الأمريكيين الأفارقة في حقبة الصراع من أجل حقوقهم إلى أن شمل حقوق المثليين وباقي الأبجدية في المعنى!. وعليه، فهذه المرأة يجب أن تثبت أنها ليست متفهمة ومتعاطفة فقط، بل مؤيدة ومشجعة!. إنها مشاعر يا سادة يا كرام، ويجب أن تقضي على أي حقائق تقف في طريقها!).
الرجل: ولما الاعتراض؟ فالذكر لا يحيض.
(المسكين يعتقد أنه ما زال يعيش في زمن الحقائق التي تعلو ولا يعلى عليها!).
الضيف: بل يحيض!
(مشاعر مرة أخرى.. إنه غارق في الوهم إلى أذنيه، ويجب على الباقي ألا يتقبله وحسب، بل دون تقديم أي اعتراض أيضًا!).
الرجل: الحقائق العلمية في علم البيولوجي تفيد بأن الذكر لا يحيض، وكون الذكر ارتدى ملابس أنثى، ووضع شعرًا مستعارا ونثر طنا من المساحيق على وجهه، لا يجعل منه أنثى!.
(ماذا؟! أما زالت «تعافر»؟! أرح رأسك يا رجل؟!).
الضيف:..وكيف لك أن تؤكد معلومتك؟! أنا متحول وأنا أحيض!
(صراحة أقنعني.. منطق وحجة قوية!).
الرجل: إن كنت تعتقد ذلك فهذا شأنك، ولكن هذا لا يغير من الواقع شيئًا، فأنت ذكر، والذكر لا يحيض!.
(انتهى أمرك، واستعد للعداء في عملك وحياتك، فلن تتُرك هكذا دون ملاحقة وتضييق وعقاب!).
المهم لن أكمل الحديث، فقد أوصلت إليكم صورة ما يحدث في الغرب من نقاشات وحوارات. كان الله في عون المدافعين عما تبقى من الحقائق التي سوف تنتحر قريبًا، ونقرأ نعيها كما قرأنا نعي الحس السليم أخيرًا.
ليس سرا أننا نعيش اليوم في عالم باتت فيه الحقائق ذاتية ومبنية على الافتراض والتخمين!. إن الحقائق - التي كان يُنظر إليها في يوم من الأيام على أنها أساس اتخاذ القرارات المستنيرة، وكأساس للفكر الذكي والنقاش المنطقي - تم إقصاؤها من الواقع، وأصبحت «كلمة ميتة»، وهذا يعني أن يتم تجاهلها بشكل متزايد، باعتبارها عقبة غير ملائمة للرؤية العصرية، حتى أن البعض بدأ التشكيك في فائدة الحقائق كليًا.
صراحة معهم حق! فلماذا نهتم بشيء يمكن التلاعب به، ليناسب أي أجندة؟!.
لا تستغربوا. إنه سؤال وجيه، فمن يحتاج إلى الحقائق عندما يمكننا أن نكيف أي معلومة لتناسب توجهاتنا؟! ما الهدف من بناء حجج على أدلة يمكن التحقق منها عندما يمكننا الصراخ بصوت أعلى من الخصم، وفي عالم حلت فيه البلاغة محل العقل بحيث يكون للرأي قيمة أكبر من الحقيقة؟!. حقًا ما الهدف من التمسك بالحقائق؟! نعم، سيكون هناك دائمًا أولئك الذين يتمسكون بمفهوم «الحقائق» غير المرتبطة بموضوع النقاش. تعرفونهم، أولئك الأشخاص الذين يطالبون بالأدلة والمصادر، وأن تكون الحجج سليمة مدعمة بالدراسات والتوثيق المعتمد، لكن في يومنا هذا من لديه الوقت لمجاراة هذا النوع من الهرطقات الفكرية؟!.
يشير المختصون إلى أنه من المرجح أن يصدق الناس المعلومات التي تؤكد معتقداتهم أو تحيزاتهم الحالية بغض النظر عما إذا كانت تستند إلى الحقائق أم لا، بل أصبحت هذه الظاهرة شائعة جدًا لدرجة أنه تمت تسميتها «التحيز التأكيدي» (يمكنكم البحث والقراءة عن المفهوم). بعبارة أخرى، نحن نصدق فقط الأشياء التي نتفق معها بالفعل! ولكن هل هذا حقا شيء سيئ؟ لماذا نهتم بالحقائق بينما يمكننا فقط اختلاق ما نريد ونسميه حقيقة؟!.
لنفكر في الأمر: كم مرة أجرينا محادثة مع شخص نختلف معه، لنجد أنه يتقدم بمعلومات يسميها «حقائق» وتتعارض تمامًا مع الحقائق التي نعرفها؟. لذا بدلا من محاولة إقناعهم بالأدلة والمنطق، أليس من الأسهل تجاهلهم وافتراض أنهم مخطئون؟. حقًا لماذا ندخل الساحة ونوجع رءوسنا، لنترك المعارك لغيرنا، و«فخار يكسًر بعضه»؟! ثم لماذا نهتم أصلًا بأي نوع من التفكير النقدي؟. يمكننا فقط إنشاء مدونات أو غرف خاصة بنا، وإحاطة أنفسنا بأشخاص ممن يفكرون مثلنا تمامًا، بحيث يمكننا أن نأخذ راحتنا بتبادل ونشر «أخبار كاذبة» عن أي فكر أو موضوع يتحدى نظرتنا للعالم، ونعلن أنفسنا المنتصرين!، وبهذا تموت حقائق «الآخر» و.. بأيدينا، وهذا لا يهم، لأن لدينا «حقائقنا». نعم قد لا تكون مبنية على المنطق أو الواقع، لكنها على الأقل تجعلنا نشعر بالرضا عن أنفسنا، فمن يحتاج إلى الحقائق عند حضور المشاعر؟!.
لقد كان للحقائق يومها، وعاشت عزها على أيدي علماء أفنوا أعمارهم في دراستها، لكنها الآن أصبحت شيئًا من الماضي.. ماذا؟ هل تريد أن تأخذ زمنها زمن غيرها؟!. نعم، قد تظهر أحيانًا في محادثة بنقاش أو حتى في ندوة، لكنها غالبًا ما تنعزل وتنزوي بين غبار أرفف المجال الأكاديمي، والمهم هنا أن نتمسك بفكرة أن الذكاء الحقيقي هو معرفة كيفية كسب المعركة.. عفوًا أقصد النقاش، وليس أن نكون على صواب!.
يا سادة يا كرام دعونا نعطي جولة من التصفيق للمستقبل الخالي من الحقائق!. إليكم عالم يكسب فيه النقاش حجمًا كبيرًا بتفوق الرأي على الأدلة والمشاعر على المنطق، وحيث إن التفكير النقدي أصبح شيئًا من الماضي، فليحيا الخيال ولتسقط الحقائق!.