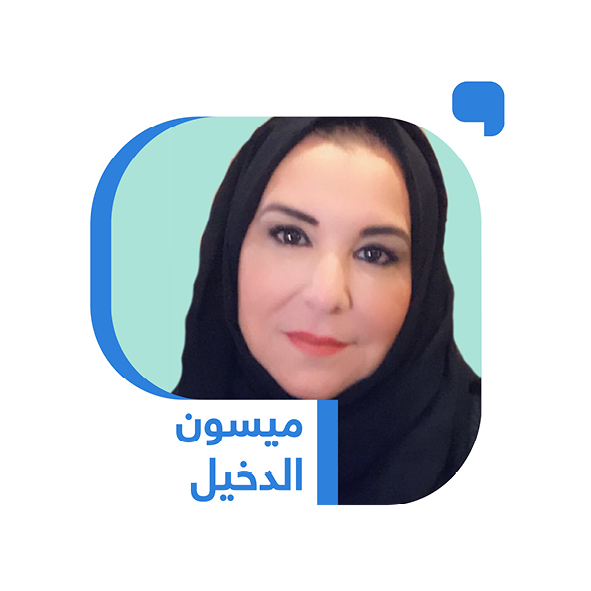قد أختار أن أعتذر، ولا أقدم أية نصيحة، وقد أتسرع في قراءة المشهد، وأصدر الحكم على طالب النصيحة، معتمدة على القاعدة العريضة من مخزون الخبرات والمعلومات، التي جمعتها، ولكن... هل أكون قد قمت بالإجراء الصحيح؟!
كثيرًا ما نغتر بأنفسنا، ونزداد انتفاخا كلما لجأ إلينا طالب نصيحة، خاصة إن كانت معظم النصائح التي قدمناها في محلها، وأثرت بشكل واضح في حياة الغير، كيف علمنا ذلك؟ لأن من ساعدنا عاد يشكر ويثني... ونسعد، ولكن مع كل مرة نحن نخسر! نعم نخسر الحكمة في التأني وفي الدراسة وفي التعمق، بل نخسر في المراجعة والتقييم لأنفسنا، فما يعكسه ثناء من هو أمامنا، يعطينا صورة مشرقة بضوء قوي، ينعكس من على سطح ذاتنا فلا نعود نرى الداخل... تماما كما ينعكس ضوء الشمس على سطح البحر فلا نرى ما بداخله!
لجأت إليّ إحدى النساء في متوسط العمر، امرأة عزباء بحياة لنقل غير عادية، بالنسبة لما هو طبيعي في مجتمعنا المحافظ، وما إن فتحت الرسالة وبدأت القراءة ساورني شعور بالانتشاء، فعلًا كنت سعيدة لأنه هنالك من يجدني جديرة بمثل هذه الثقة: أن تفتح إحداهن صفحات حياتها وتعريها أمامي بكل هذه الجرأة!
أول ما طرأ على بالي بعد الانتهاء من القراءة، هو اللوم وإمطارها بالأسئلة الاستجوابية، وكأنني محقق يجلس أمام متهم، وقد حكم عليه مسبقًا بأنه مذنب!
ولكن شيئًا ما دفعني إلى أن أغلق الرسالة، وألتفت إلى ما كنت على وشك البدء في عمله، ألا وهو تحضير مقالة الأسبوع الماضِي. ما فعلته هو أني اخترت... اخترت أن أعطي لنفسي فرصة أن أرى الحياة من وجهة نظرها... أي أن أسير مرتدية حذاءها، كما يقال في الغرب في مثل هذه المواقف، ماذا تريد هي وليس ما أريده أنا!
أخذت الوقت الكافي لأدير الأمر برمته في خاطري، ومن ثم أخذت وقتًا إضافيًا، وعندما عدت للتفكير بها، سألت نفسي: «ماذا أريد أن أظهر هنا؟ أي ثوب سوف أرتديه، ثوب الداعية أم ثوب المرشد الاجتماعي؟ هل أريد أن أعرض عضلاتي لذاتي، حتى أشعر بالراحة والانتشاء:
«انظري هنا أيتها البائسة، أنظري يا من أرى أنني أفضل منك، أنظري هنا يا من تجرأ وأضل الطريق؟»، وسألت ذاتي أيضًا: «وماذا إن كنت حقًا أريد لها الراحة بالرغم من اشتعال رغبة الواعظ بداخلي؟»... ثم هل أنا ملاك؟!
وزنت الأمر ورأيت بما أنها لجأت للنصيحة، فهي تدرك أين هي، وتدرك بأنها عليها اتخاذ قرارات حازمة تجاه التغيير، وبما أنها سطرت فهذا أول طريق التحول، الخطوات التالية لن تكون نابعة مني أو بسببي بل من داخل أعماقها، وما كانت تحتاجه هو كيف ومن أين تبدأ، وهذا ما أرسلته:
«عزيزتي لا أحد يستطيع أن يساعدك سوى ذاتك.
أنتِ من يقرر ما تريدين بالضبط.
عليك أولا أن تحددي أهدافك في الحياة، وتضعي لها خطة تفعيل ومدة زمنية ومؤشرات إنجاز.
ثانيا عليك أن تعيدي بناء هرم القيم لديك، بناء على أهدافك وليس اهتماماتك الوقتية.
اجلسي مع نفسك وحددي أين تريدين أن تكوني خمسة أعوام من الآن.
ولا تنسي أن تفكري بـ «أين سوف تكوني إن استمررتِ على نمط الحياة الذي تتبعينه الآن».
زِني وقيمي واستعيني بالله، ثم توكلي عليه وتحركي إلى الأمام، حتى ولو كان ذلك بداية جديدة.
ادرسي نمط حياتك جيدًا، وتعرفي على الأسباب التي تجعل الآخر يستقبل رسائل سلبية عنك.
مفتاح حياتك بيدك فانشدي الأبواب التي تفتح لك طريق المستقبل الآمن.
لقد جربتِ كما تقولين التحرر فقيمي النتائج... والقرار لك.
أتمنى لك كل التوفيق، وأدعو الله أن ينير لك بصيرتك، ويرشدك إلى طريق يحبه ويرضاه.
ولك مني كل الود والمحبة».
لم أذكر أيا مما قامت به في الرسالة ولم أصدر أي حكم، تركت ذلك لها، فلو أنني كتبت أي كلمة لوم أو عبارة سلبية، لكنت خسرتها، وهذا بالطبع ما لم أكن أريده، أردت أن يكون الحل من داخلها... ذاك الداخل الذي شعر بالحاجة للتغيير، وفي انتظار إشارة على أنه على الطريق الصحيح.
نعمة الاختيار لم تمنح من الخالق سبحانه بدون سبب، فكل لحظة من الحياة تسألك من أنت الآن؟.. وإذا لم تعجبك الإجابة – بيدك الاختيار حتى تتغير الإجابة! نعم الأمر ليس دائمًا سهلًا، فالحياة غالبا ما تجذبك في اتجاهين متعاكسين، ما بين رغبات جسدية وروح تقية، ميل يشدك للاختيار بحكمة على الرغم من صعوبته، وميل يشدك إلى السقوط بكل إغراءاته، والقرار دائما لك.