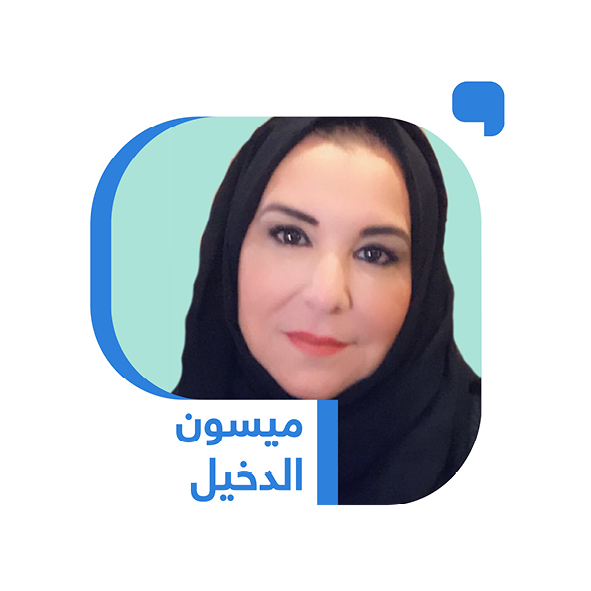قرأت مؤخرا عن قصة رجل شارك في حملة البحث عن نفسه. في بلدة نائية، خرج رجل في الواحدة والخمسين من عمره لقضاء وقت مع صديقه في الغابة، كلا لم يكن للصيد، بل للشرب والتسلية بعيدا عن أعين الناس، وعندما لم يعد إلى المنزل قدمت زوجته بلاغا إلى الشرطة عن اختفائه، كانت تعلم عن عادته في الشرب لكنه كان في كل مرة يعود، وهذه المرة حينما تأخر وطالت غيبته راودتها المخاوف بأن شيئا ما قد حدث له. من المعروف أن الشرطة عادة لا تتحرك إلاّ بعد مرور 24 ساعة على الأقل من الاختفاء، طبعا في حالة اختفاء الأطفال فعامل السرعة مهم في التدخل من أجل الإنقاذ، خاصة إن كان هناك شك أنها حالة خطف، لكن في حالة أخينا لسبب ما تحركت الشرطة بسرعة، وبينما كان المفقود غاطسا في نوم عميق بالغابة، تم استدعاء القوات العسكرية وفرق الإنقاذ للبحث عنه، الطريف بالأمر هنا أن الرجل استيقظ ليجد إحدى فرق الإنقاذ تمر بجانبه، فأخذته الحمية وقرر أن يساهم في البحث عن الشخص المفقود، وما إن أصبح بينهم سمعهم ينادون باسمه، هنا أدرك أنه كان هدف عمليات البحث. حاول أن يُفهم الفرقة بأنه هو المطلوب؛ أي الشخص الذي كانوا يبحثون عنه، لكن لم يصدقه أحد وواصلت الفرق عملها، وهنا لم يشأ أن يظهر وكأنه تخلى عن المهمة النبيلة فاستمر في البحث عن نفسه لأكثر من نصف ساعة، ولم يتوقف البحث حتى ظهر صديقه الذي كان ضمن فرقة أخرى وتعرف إليه.
لنحول هذه القصة إلى درس من الحياة، كيف أننا دائما في بحث دائم عن ذواتنا داخل غابة الزمن وفي دوائر الحياة وفي أعين الناس من حولنا، نجد أننا في كثير من الأحيان نشارك الفرق في البحث عن أنفسنا دون أن نتوقف، لنفكر أن من نبحث عنه ليس داخل دائرة البحث، بل داخل أنفسنا.
نحن في عطش دائم لملء ذاك الفراغ الذي يأخذ حيزا من روحنا، نتوق إلى شيء ما يصعب علينا الإشارة إليه أو حتى تعريفه، لكننا ندخل في أتون الحياة ونندرج مع المجاميع بحثا عنه؛ من خلال التواصل والتفاعل، وكلها عمليات خارجية بعيدة كل البعد عن المكان الذي يجب أن نبدأ منه، وكأننا نتحاشى الحديث مع ذواتنا. نخاف أن تصدمنا إن أدركنا حقيقة لا نريد أن نعرفها، فكيف يكون الهروب؟. من خلال التركيز على أمور أخرى مثل الطعام أو الحمية، الرحلات أو الترفيه بأنواعه، ووسائل التواصل الاجتماعي أو حتى الرياضة، وقد يصل عند البعض إلى حد الإدمان!. يجب أن تدور الدوامة حتى لا نتوقف ونجد أن من يستحق أن نتعرف إليه وأن نحلله هو من تعكسه مرآتنا حين نقف وحيدين أمامها.
إن فعلت، كن صادقا واسأل ذاتك ماذا ترى؟ تحاور معها، خذ الوقت الكافي للإجابة بوضوح واقتناع على هذه الأسئلة: هل تسببت في جروح، هل غرست سهامك في الندوب، هل تعيش على بؤس الآخرين وترتوي من نزف القلوب، هل تشعر وكأن العالم يتساقط فوق رأسك، هل أنت بلا مشاعر، هل خدرت مشاعرك فبت جامدا لا تقوى على التفاعل، هل ترتدي الأنانية وتتشح بالنرجسية، هل تشعر بتأنيب الضمير لأمر لم ترتكبه، هل تشعر بالارتباك والتشتت؟ من أنت حقًا؟ هل أنت قصيدة حب ضائعة بين أرصفة الحياة، هل أنت العطاء الذي لا يُقّدر، هل تشعر بحمل العالم على كتفيك ولا تجرؤ على طلب حضن يحتويك؟.
وللإجابة عن هذه الأسئلة الحساسة وغيرها مما يطرأ على ذهنك، من الضروري قضاء بعض الوقت في إجراء مقابلة صادقة مع أروع شخص يمكن أن تقابله في هذا العالم...أنت!. كن من تكون وتقبل ما يتجلى لك، ولا تخجل فالكمال لله سبحانه، المهم أنك ستكتشف ما سوف يبهرك، فقط توقف وخذ نفسا عميقا وأبحر داخل ذاتك، أخمد نيران الكراهية إن وجدت.. وأشعل نيران المحبة إن خمدت، حتى تتوهج وتنير حياتك وحياة من حولك. ذاتك المثيرة في ترقب وعطش كي تكتشفها، فتوقف عن البحث عنها في فرق الآخرين، وحول اهتمامك وتركيزك إلى الداخل حيث ستجدها في انتظارك، وعندها ستجد أن ذاك الفراغ قد بدأ بالامتلاء.