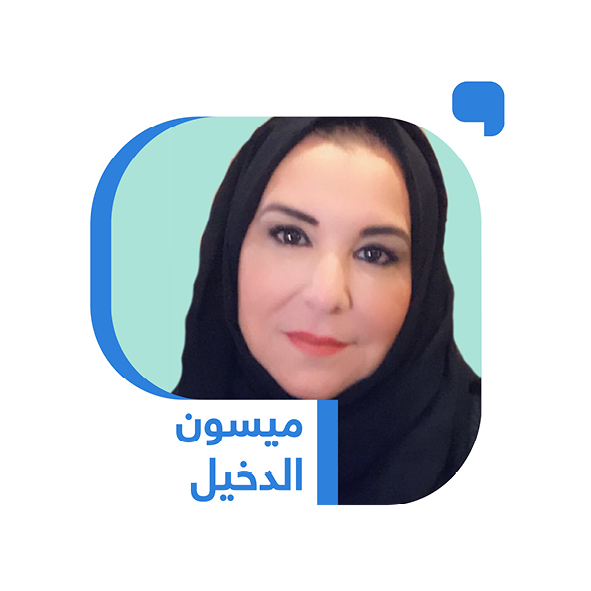هذا ما كتبته يوما حينما طلب مني أن أكتب، أن أعبر عما أشعر به حينما أفكر بصديقتي الحميمة، وأنا ـ ولله الحمد ـ قد مَنّ علي الله بعدد لا بأس به منهن، ففي مسيرة حياتي مررت بخبرات كثيرة، وفي كل مرحلة كانت هنالك إنسانة تركت بصمتها عميقة في صفحات قلبي، ولم يكن غريبا عليّ أن أتقبل كل واحدة منهن على ما هي عليه، رغم الفوارق الكثيرة بيننا أحيانا، في الأفكار، في المواقف، في التوجهات، أو حتى في السمات الطاغية على كل واحدة منا، المهم أننا التقينا على محبة وثقة وعطاء، لا نقوم بتحليل بعضنا البعض، لأنه ببساطة لسنا بحاجة إلى ذلك. تقبلنا بعضنا البعض لِما نمتلكه من صفات إيجابية كانت أو سلبية، لا شيء في الخفاء، فنحن نعرف جيدا نقاط القوة ونقاط الضعف لدى كل منّا، لسنا في علاقة تنافسية، ولا نسعى لكي نكسب أو نستفيد، بل نضيف وننمو معًا، نحترم خصوصية وفردية بعضنا البعض، بل أبعد من ذلك نتفهم أوجه التشابه ونحترم الاختلافات.
أساس هذا النوع من الصداقة هو الثقة، فإن وقعت إحدانا في مشكلة، فلن تفكر الأخرى مرتين قبل أن تسارع إلى مد يد العون حتى ولو كانت تفصل بينهما مسافة طويلة، فبالنسبة إليهن هذه المسافة ليست سوى مساحة من الجغرافيا تأتي مع الحياة، رغم ذلك يبقى الاتصال مستمرا ولا يتلاشى مع مشاغل الحياة، بل تنمو العلاقة وتزدهر بشكل أقوى وأعمق عبر السنين، لدرجة أن مجرد سماع نبرة الصوت عبر الهاتف تستطيع إحداهن أن تشعر بالحالة التي لم تمر بها، وإن لم يُذكر لها أي شيء عنها، حتى الصمت يقرأ ويفهم. إنه الرابط الروحاني الذي يوصل بينهما ويحافظ على نسيج هذه الصداقة ويجعله متينا غير قابل للشرخ أو حتى الدفاع عنه، إنه نبض القلب الذي لا يشعر به سوى من تجري في عروقها دماء مزجت بحبر يخرج من دواة الحياة، من أفراح وأتراح وفشل وأدمع وابتسامات وألم وضحكات وانكسار وأمل، نعم بالقلب نفهم معنى أن تكوني صديقة أو أن تكون لديك صديقة!
إنها ليست رفاهية، هي جهد أيضا، مع تطورها ننمو في أحضان هذه النعمة، ونتعلم أن نحب ونعتني، أن نعطي ونستقبل، أن نتشارك الأفكار والمشاعر دون خوف من الحكم أو النقد، فنحن بحاجة إلى من يمكننا مشاركة حياتنا وأفكارنا ومشاعرنا وإحباطاتنا معها، نحتاج إلى من تصغي إلينا ونحن نتحدث عمّا يقلقنا أو يسعدنا، بل ما يثقل أنفسنا من أسرار يحملها عنا ويساندنا بالنصيحة والتوجيه دون القلق من أن تصبح تلك الأسرار خبرا يشاع عند كل من لديها استعداد للنشر والتشفي. إنها تتحمل مسؤولية سلوكياتنا وتعدياتنا بقصد كانت أو من دون قصد، إنه الاستعداد للاعتذار والتسامح: «آسفة لأنني جرحت مشاعرك»، تفتح أبواب استعادة السلام والتواصل من جديد.
قد تأتي الصداقة الحميمة في أسفل التسلسل الهرمي للعلاقات، فقبلها الوالدان، والشريك، والأبناء، ولكن هذا لا يقلّل من وهجها وتأثيرها في النفس وفي الروح، إنها وليدة اختيار وليست فرضا أو واجبا، قد لا تستطيع أن تبتعد لأشهر، بل أحيانا لأيام أو ساعات عن إحدى حلقات العلاقات مثل الأم أو الشريك أو الأبناء، ولكن قد تمضي سنوات دون الاتصال بصديق، ورغم ذلك عند أول اتصال تشعر وكأن شيئا لم يفرقكم لا الوقت ولا المسافات.
نكبر وتأخذنا الحياة في دوامة العمل والأسرة والمسؤوليات الاجتماعية، وقد تكبر شبكة المعارف والأصدقاء العابرين، لكن الصداقات الحميمة تبقى كما هي لا تتضرر، الفارق أنه في السابق كنا نهرع إلى رؤية بعضنا البعض دون تخطيط أو ترتيب، أما اليوم فنحتاج في كثير من الأحيان أن نسأل إن كانت لديها فرصة للقاء، لأن الصداقة الحميمة تعني أنه لدى كل منّا استعداد للتسامح رغم الانقطاعات الطويلة في التواصل، فمن منّا لا تشعر بحمل سرعة الحياة وكثرة متطلباتها وتنوعها؟! لكن التي تقدر وتتفهم هي التي تجعل من الصداقة علاقة بلا قيود، علاقة تعني أنك لا تختفين عند الحاجة إلى أن تقدمي أفضل ما لديك من قدرات وإمكانيات بين يدي الصديقة.
لصديقاتي الحميمات اللائي يزين عقد الصداقة اللؤلؤي الذي يطوق ويجمل روحي، لمن أنعم الله عليّ بمشاركة أرواحهن الشفافة ونفوسهن الطيبة المعطاءة، لمن مسحن أدمعي وقت فشلي وأحزاني وآلامي، لمن شاركني كل فرحة من أفراحي وانتصاراتي، وصفقن لها وباركن كل خطوة من خطواتي بغض النظر عن حجمها، لأنه بالنسبة إليهن كان كل تقدم إنجازا يستحق الإشادة والدعم والتقدير، لأولئك أقول: «لماذا اخترتكن؟.. لأنكن أنتن.. ولأنني أنا».